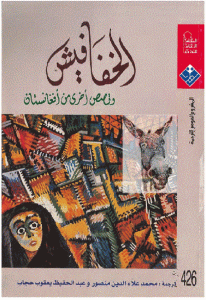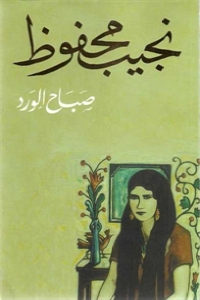كتاب موزاييك دمشق 39 – رواية لـ فواز حداد
 |
| كتاب موزاييك دمشق 39 – رواية اللغة : العربية دار النشر : الأهالي للطباعة والنشر سنة النشر : 1991 عدد الصفحات : 250 نوع الملف : مصور |
حول الكتاب
أطلق العنان لأفكاره، مرتاحاً للطبيب الذي تنصّل من معتقدات العوام والمغاربة: “شام شريف… ما الذي يجعل هذا المكان مقدّساً، الجامع الأموي الذي بناه العرب فوق أنقاض كنيسة، أم قبر السيدة زينب وصلاح الدين الأيوبي، أو التكايا والقبب التي شيّدها الأتراك؟”. كان الطبيب قد أضاع، والكولونيل يمسكه ويفلته، المسافة الصحيحة التي يجب أن تفصله عنه، تارة يسمعه ولايراه، وتارة يراه ولا يسمعه، واقفاً عند الوصيد يرتعها، الإعياء بادٍ على أطرافها، وحبات العرق تبلل جبهتها وصدغتها. والكولونيل أخذته حمّى التاريخ ورعشة الجغرافيا وتكاليف الحضارة الباهظة.
“سوريا تسقط في واقعها، وماهي إلّا فُسيفساء غريبة وغير متجانسة من الديانات والمذاهب والأجناس والأقوام والعشائر، المسلمون بفرقهم المتعددة وخلافاتهم المعقّدة، والمسيحيون بملَلِهم المتنابذة، حتى أن البروتستانت وجدوا لهم مكاناً فيها، عدا اليهود والأرمن والأكراد والشركس والتركمان والآشوريين والسريان والبخاريين والروس البيض” تمنى في هذه اللحظة أن يعيد أداء ما جرى، وقد ساوره الظنّ في أنّها لم تكن مشرفة على الموت، على الرغم من حيل الوهن والسُبات.. ونزف لم يكن مسوّغ كي يراها.
“يجب فهم هذه الكيانات الصغيرة، ولا نسعى لطمسها كما فعل الأتراك”. لام نفسه على طلبه من المرأة أن تجسّ لها جبينها. بادر يجري تعديلاته، تجاهل المرأة، واقترب من الفتاة واضعاً راحته على جبهتها، أمسك معصمها، وغار في صمتها، يستنطقها، يُظهر عدم ارتياحه، يفتح حقيبته، يتناول السماعة، يضعها على أُذنيه ويكشف فتحة الثوب…
“فرنسة لن تخرج من سورية، رسالتها تأهيل السوريين وإدخالهم من جديد في التاريخ الذي يُصنع على الطرف المقابل، لا يفصلهم عنه سوى البحر”. يضع السماعة على القلب تماماً، باحثاً عن صوت نبضاتها دون جدوى. صمت الكولونيل فجأة، معجباً بالروح العالية للطبيب الذي يُصغي بانتباه كامل دون أن يقاطعه، أحسّ أنّه يستطيع التفاهم معه دون محاذير كبيرة، بعدما اكتشف الأرضية المشتركة التي يقفان عليها، ومن الأفضل أن يبدأ من فوقها. فأخذ يشرح له أن العلمانية التي أنقذت أوروبا من الكنيسة ومحاكم التفتيش، مدعوة الآن كي تنقذ سورية من أوهامها كافة دون تمييز، مع أنّ مهمة المسيو بيو في سورية، تبدو شاقّة بعد تصريح غاستون في البرلمان الفرنسي بأن فكرة المعاهدة خاطئة في حدّ ذاتها.
“ولكننا إذا دققّنا النظر فسوف نجد أنّ النكول عنها ما هو إلّا إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، لا معاهدة، والمعاهدة التي تصرّ الكتلة على إبرامها لا تؤهل سورية للمدنية بقدر ما سوف تفلت العنان لانقسامها وتناقضاتها لتظهر على السطح. نحن نأمل بسلام حقيقي وصداقة دائمة بين سورية وفرنسة. أعتقد أنّه في هذا الجو من التفاهم الكامل يستطيع السوريون أن يمخرون عباب البحر الأبيض المتوسط نحونا”.
لم يفلح الطبيب، والفتاة تسخر من سلسلة فحوصاته المرتجلة من جهة، والكولونيل يشدّه بسياساته المتحررة والطموح من جهة أخرى، مجاراة المواقف المغلقة والمفتوحة التي نشأت على حين غرة من التداعيات الطريفة التي أوقع نفسه فيها.. لكن والفتاة تفتح عينيها، شدهته، ظهرتا أكثر اتساعاً وأشدّ جمالاً ممّا كان يتخيل، لم يستطع إلّا أن يعقّب بشكل مقتضب، حتى لا يفسد روعة مشاهداته.
“كولونيل كولبير، ليس المهم أن تكونوا صريحين، وإنما أن تكونو مفهومين، ما يفصلنا عنكم شرخ أعمق من البحر الذي أشرتُ إليه، إنّ النوايا الطيبة والسيئة معاً لا تكفي لفرض مصير ما على سورية دون موافقة السوريين أنفسهم”. اعتقد الطبيب أن هناك رجلاً ثالثاً صاغ هذا التعبير الموفق، واعتبر الكولونيل أنّ العبارات الطائشة والحكيمة التي سمعها كانت في منتهى الرعونة.. أكمل متظاهراً أنّه لم يسمع ملاحظته الجافة: “إن تعاوننا مع الشيخ تاج قد أثمر خطوات عمرانيّة مهمّة في البلاد، وما بناء مدرسة التجهيز ووزارة الصحة والمعهد الطبي الانتاج حكمته”. لم يُظهر الطبيب تقديره لتلك السابقة العاقلة، بعدما انصرف بكليّته عن المكان.
تبادر للكولونيل أنّ الشخص الجالس مواجهته قد وضع على وجهه قناعاً من اللامبالاة، لذا علا صوته بحيوية محتجّاً على التغيرات الملموسة التي طرأت عليه بعد ليلة البارحة: “هل تستطيع عناصر الكتلة الوطنية وعصبة العمل القومي والشهبندر بخلافاتهم المستحكمة، أن يقودوا سورية إلّا إلى مزيد من الفوضى؟ لا تنسَ أنّ فرنسا على أعتاب الحرب، ولديهم فرصة نادرة ومحدودة لبداية جديدة، وإذا كانوا يهيئون لشغب يعمّ البلاد فهم مخطئون، الإضطرابات لن يدعها الإنكليز، سوف يدخلون الحرب معنا ضد ألمانيا، والأتراك سيقفون على الحياد متفرجين ومتذرعين بشتى الأكاذيب، ولواء اسكندرون.. تلك المشكلة العالقة سوف نستغلّها سلباً وإيجاباً”. ظلّ الطبيب ساهماً على الرغم من أنّه كان يسمعه بوضوح، هذه حالة لم يكن الطبّ مدعوّاً لإيجاد علاج لها، الكولونيل يساهم عن قصد بتعقيد الأمور المعقّدة أصلاً، مستغلّاً الحرب والاتفاقيات السريّة، محاولاً أن يزجه داخلها دون مبرر، عدا أنّه يمنعه من التركيز المتأني على ابتداع الحجة المعقولة التي سيطرق بها باب بيت سرحان”.
يأخذك الكاتب عبر التاريخ… تحلو لك مرافقته.. وتمضي معه لتعيش أجواء ومناخات دمشق39 وهي تستعدّ للنهوض من تحت ركام لوعات الانتداب الفرنسي.. تسير في شوارع دمشق39.. وفي حاراتها وأزقّتها.. تتوالى المشاهد الاجتماعية.. الاقتصادية والسياسية لترمي بثقلها من خلال استحضارا الكاتب لأسماء لمعت في تلك الفترة.. الكتلة الوطنية… الشهبندر، محمد علي العابد، حقي الظم، هاشم الأتاسي… كما وأسماء الشخصيات اصطفّها الكاتب لتساهم في إعطاء صورة لدمشق في تلك الفترة، من خلال هذا العمل الروائي… أحداث تتوالى.. ومشاهد تتبدّل بتبدل الأحداث… وأنت وكقارئ تعيش حالة تاريخية، متأرجحاً بين الواقع والخيال.. بين الحقيقة والحلم.. بين ماضي دمشق وحاضرها مستثيراً داخلك ألماً ولوعة وحسرة.. وتساؤل مُلح: هل يعيد التاريخ نفسه، مع تغيّر في الأسماء والأدوار والأحداث.. والمصطلحات السياسية والاستعمارية؟؟!!
“سوريا تسقط في واقعها، وماهي إلّا فُسيفساء غريبة وغير متجانسة من الديانات والمذاهب والأجناس والأقوام والعشائر، المسلمون بفرقهم المتعددة وخلافاتهم المعقّدة، والمسيحيون بملَلِهم المتنابذة، حتى أن البروتستانت وجدوا لهم مكاناً فيها، عدا اليهود والأرمن والأكراد والشركس والتركمان والآشوريين والسريان والبخاريين والروس البيض” تمنى في هذه اللحظة أن يعيد أداء ما جرى، وقد ساوره الظنّ في أنّها لم تكن مشرفة على الموت، على الرغم من حيل الوهن والسُبات.. ونزف لم يكن مسوّغ كي يراها.
“يجب فهم هذه الكيانات الصغيرة، ولا نسعى لطمسها كما فعل الأتراك”. لام نفسه على طلبه من المرأة أن تجسّ لها جبينها. بادر يجري تعديلاته، تجاهل المرأة، واقترب من الفتاة واضعاً راحته على جبهتها، أمسك معصمها، وغار في صمتها، يستنطقها، يُظهر عدم ارتياحه، يفتح حقيبته، يتناول السماعة، يضعها على أُذنيه ويكشف فتحة الثوب…
“فرنسة لن تخرج من سورية، رسالتها تأهيل السوريين وإدخالهم من جديد في التاريخ الذي يُصنع على الطرف المقابل، لا يفصلهم عنه سوى البحر”. يضع السماعة على القلب تماماً، باحثاً عن صوت نبضاتها دون جدوى. صمت الكولونيل فجأة، معجباً بالروح العالية للطبيب الذي يُصغي بانتباه كامل دون أن يقاطعه، أحسّ أنّه يستطيع التفاهم معه دون محاذير كبيرة، بعدما اكتشف الأرضية المشتركة التي يقفان عليها، ومن الأفضل أن يبدأ من فوقها. فأخذ يشرح له أن العلمانية التي أنقذت أوروبا من الكنيسة ومحاكم التفتيش، مدعوة الآن كي تنقذ سورية من أوهامها كافة دون تمييز، مع أنّ مهمة المسيو بيو في سورية، تبدو شاقّة بعد تصريح غاستون في البرلمان الفرنسي بأن فكرة المعاهدة خاطئة في حدّ ذاتها.
“ولكننا إذا دققّنا النظر فسوف نجد أنّ النكول عنها ما هو إلّا إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، لا معاهدة، والمعاهدة التي تصرّ الكتلة على إبرامها لا تؤهل سورية للمدنية بقدر ما سوف تفلت العنان لانقسامها وتناقضاتها لتظهر على السطح. نحن نأمل بسلام حقيقي وصداقة دائمة بين سورية وفرنسة. أعتقد أنّه في هذا الجو من التفاهم الكامل يستطيع السوريون أن يمخرون عباب البحر الأبيض المتوسط نحونا”.
لم يفلح الطبيب، والفتاة تسخر من سلسلة فحوصاته المرتجلة من جهة، والكولونيل يشدّه بسياساته المتحررة والطموح من جهة أخرى، مجاراة المواقف المغلقة والمفتوحة التي نشأت على حين غرة من التداعيات الطريفة التي أوقع نفسه فيها.. لكن والفتاة تفتح عينيها، شدهته، ظهرتا أكثر اتساعاً وأشدّ جمالاً ممّا كان يتخيل، لم يستطع إلّا أن يعقّب بشكل مقتضب، حتى لا يفسد روعة مشاهداته.
“كولونيل كولبير، ليس المهم أن تكونوا صريحين، وإنما أن تكونو مفهومين، ما يفصلنا عنكم شرخ أعمق من البحر الذي أشرتُ إليه، إنّ النوايا الطيبة والسيئة معاً لا تكفي لفرض مصير ما على سورية دون موافقة السوريين أنفسهم”. اعتقد الطبيب أن هناك رجلاً ثالثاً صاغ هذا التعبير الموفق، واعتبر الكولونيل أنّ العبارات الطائشة والحكيمة التي سمعها كانت في منتهى الرعونة.. أكمل متظاهراً أنّه لم يسمع ملاحظته الجافة: “إن تعاوننا مع الشيخ تاج قد أثمر خطوات عمرانيّة مهمّة في البلاد، وما بناء مدرسة التجهيز ووزارة الصحة والمعهد الطبي الانتاج حكمته”. لم يُظهر الطبيب تقديره لتلك السابقة العاقلة، بعدما انصرف بكليّته عن المكان.
تبادر للكولونيل أنّ الشخص الجالس مواجهته قد وضع على وجهه قناعاً من اللامبالاة، لذا علا صوته بحيوية محتجّاً على التغيرات الملموسة التي طرأت عليه بعد ليلة البارحة: “هل تستطيع عناصر الكتلة الوطنية وعصبة العمل القومي والشهبندر بخلافاتهم المستحكمة، أن يقودوا سورية إلّا إلى مزيد من الفوضى؟ لا تنسَ أنّ فرنسا على أعتاب الحرب، ولديهم فرصة نادرة ومحدودة لبداية جديدة، وإذا كانوا يهيئون لشغب يعمّ البلاد فهم مخطئون، الإضطرابات لن يدعها الإنكليز، سوف يدخلون الحرب معنا ضد ألمانيا، والأتراك سيقفون على الحياد متفرجين ومتذرعين بشتى الأكاذيب، ولواء اسكندرون.. تلك المشكلة العالقة سوف نستغلّها سلباً وإيجاباً”. ظلّ الطبيب ساهماً على الرغم من أنّه كان يسمعه بوضوح، هذه حالة لم يكن الطبّ مدعوّاً لإيجاد علاج لها، الكولونيل يساهم عن قصد بتعقيد الأمور المعقّدة أصلاً، مستغلّاً الحرب والاتفاقيات السريّة، محاولاً أن يزجه داخلها دون مبرر، عدا أنّه يمنعه من التركيز المتأني على ابتداع الحجة المعقولة التي سيطرق بها باب بيت سرحان”.
يأخذك الكاتب عبر التاريخ… تحلو لك مرافقته.. وتمضي معه لتعيش أجواء ومناخات دمشق39 وهي تستعدّ للنهوض من تحت ركام لوعات الانتداب الفرنسي.. تسير في شوارع دمشق39.. وفي حاراتها وأزقّتها.. تتوالى المشاهد الاجتماعية.. الاقتصادية والسياسية لترمي بثقلها من خلال استحضارا الكاتب لأسماء لمعت في تلك الفترة.. الكتلة الوطنية… الشهبندر، محمد علي العابد، حقي الظم، هاشم الأتاسي… كما وأسماء الشخصيات اصطفّها الكاتب لتساهم في إعطاء صورة لدمشق في تلك الفترة، من خلال هذا العمل الروائي… أحداث تتوالى.. ومشاهد تتبدّل بتبدل الأحداث… وأنت وكقارئ تعيش حالة تاريخية، متأرجحاً بين الواقع والخيال.. بين الحقيقة والحلم.. بين ماضي دمشق وحاضرها مستثيراً داخلك ألماً ولوعة وحسرة.. وتساؤل مُلح: هل يعيد التاريخ نفسه، مع تغيّر في الأسماء والأدوار والأحداث.. والمصطلحات السياسية والاستعمارية؟؟!!