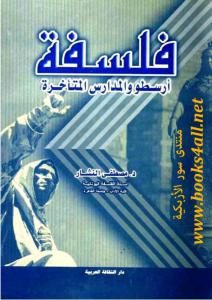كتاب أبرياء في الخارج لـ مارتن إندك
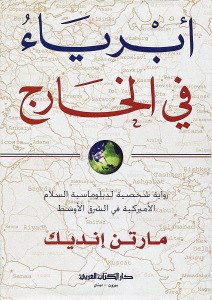 عنوان الكتاب:أبرياء في الخارج
عنوان الكتاب:أبرياء في الخارجالمؤلف:مارتن إندك
ترجمة:عمر سعيد الأيوبي
الناشر: دار الكتاب العربي
رابط التحميل:حمل من هنا
وفي هذا الكتاب يركز إنديك، أساساً، على عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، كونه كان شاهداً عليها، ويوصّف، من وجهة نظره، الدور الأميركي في العملية السلمية الشرق أوسطية، فهو كان له دور بارز في حث كلينتون على إجراء تغيير جذري في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهزيمة صدام حسين.
ويلخص إنديك في كتابه أعواماً ثمانية من جهود إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون لإحلال السلام في المنطقة، مركزاً على عناصر النجاح والإخفاقات التي اعترضت طريق المسيرة السلمية في الشرق الأوسط، منتقداً في الوقت ذاته سياسة جورج دبليو بوش. |
ويسعى إنديك في هذا الكتاب إلى رسم خارطة طريق إلى الإدارة الأميركية التي تسعى إلى إحلال السلام بين الأفرقاء في المنطقة، وكأنه في ثنايا ما يكتب يسويق نفسه للإدارة الجديدة التي تسلم زمام قيادتها باراك أوباما.
وإنديك أكاديمي الأسترالي من أصول بريطانية هاجر إلى الولايات المتحدة ودرس لمدة عام في جامعة كولومبيا عام 1982، ثم أسس “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” قبل أن يعمل مع إدارة كلينتون التي بعدما تم منحه الجنسية الأميركية. وشغل إنديك منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، وتم تعيينه سفيراً لواشنطن في إسرائيل. لكنه، حالياً يشغل مدير “مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط” التابع لـ “معهد بروكينغز”.
“الراي” تعرض أبرز ما ورد في مقدمة كتاب إنديك، فضلاً عما نُشر عن هذا الكتاب في “النيويورك تايمز” و”الفورين أفير”.
يستهل إنديك مقدمة كتابه بالقول: “في وقتنا الراهن، الذي نلاحظ فيه أن عناوين الأخبار الواردة من منطقة الشرق الأوسط مفعمة بسفك الدماء والإرهاب والحروب الطائفية والنزاعات الأهلية والتهديدات بتدمير دولة إسرائيل، يبدو من الصعب علينا أن نتخيل أنه قبل فترة ليست بالطويلة شهدت سياسة المنطقة علامة فارقة تمثلت في مراسم التوقيع التي أقيمت في البيت الأبيض الأميركي، وهي المراسم التي عبر خلالها قادة عرب وإسرائيليون عن التزامهم المشترك إزاء السلام والمصالحة. وصحيح أن المتنفذين والمشككين راحوا لاحقاً يسخرون من مثل تلك المناسبات ويصفونها بأنها ليست سوى “جلسات لالتقاط الصور التذكارية”، وكأنه لم يكن لها أي أهمية أكبر من ذلك. ولكن الآن، وبالنظر إلى الحال المزرية التي تعيشها الشؤون الشرق أوسطية، حالياً، فإنه ينبغي استعادة ذكرى تلك المراسم باعتبارها كانت مؤشرات لما كان ممكناً عندما استطاع قادة عرب وإسرائيليون – تحت رعاية رئيس أميركي – أن يتعهدوا بالتزام دولهم إزاء مبدأ تسوية الخلافات من خلال عملية صنع السلام”.
ويضيف: “ان المصافحة، التي تمت بين إسحق رابين وياسر عرفات في البيت الأبيض بتاريخ 13 سبتمبر 1993، يُنظر اليها عادة باعتبارها كانت لحظة الذروة بالنسبة إلى تلك الحقبة. لكن ذلك الأمر كان في البداية، لأن رابين بدا غير متحمس لمصافحة عرفات (ثم صافحه على مضض). وفي واقع الأمر فإن نقطة الذروة في عملية السلام جاءت بعد مرور عامين على تلك المصافحة، وتحديداً بتاريخ 28 سبتمبر 1995 وذلك عندما ذهب رابين وعرفات إلى البيت الأبيض مرة ثانية كي يوقعا اتفاقية (أوسلو 2) التي فتحت الطريق أمام إحلال الحكم الفلسطيني محل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والبلدات الرئيسية في الضفة الغربية. وفي تلك المناسبة، حضر الرئيس المصري حسني مبارك ليكون شاهداً على مراسم التوقيع. ووقف العاهل الأردني (الراحل) الحسين بن طلال بافتخار إلى جوار رابين – وكان الاثنان قد وقعا قبل ذلك بسنة اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية… وفي تلك المرة، كان المشاهدون على موعد مع إيماءة عفوية جاءت مختلفة تماماً عن أجواء الصلابة التي كانت قد خيمت على المناسبة الأولى. تلك الإيماءة حصلت عندما وضع عرفات ذراعه بمودة على ظهر رابين، أما رابين – المعروف عنه أنه رجل خجول وليس لديه وقت في العادة لإبداء مثل تلك الإيماءات العاطفية – فإنه ترك ذراع عرفات على حالها ولم يبادله الإيماءة بينما غادرا الغرفة معاً”.
ويتابع: “في وقت لاحق من تلك الليلة أقام الرئيس بيل كلينتون حفل استقبال على شرف صناع السلام في قاعة كوركوران غاليري التي تقع على الجهة المقابلة في الشارع نفسه الذي يطل عليه البيت الأبيض. وفي تلك القاعة الفخمة المزدانة بالأعمدة المزخرفة، اختلط عدد كبير من السياسيين والديبلوماسيين وأعضاء جماعات الضغط الواشنطنيين مع ممثلي الجاليات اليهودية وجاليات الأميركيين ذوي الأصول العربية. وبعد برهة من الوقت ظهر الرئيس كلينتون ونائبه آل غور جنباً إلى جنب مع الزعماء (العرب واليهود) على منصة في الطرف الجنوبي من القاعة الفخمة كي يتحدثوا إلى الحضور. لم يكن عرفات ورابين قد توقعا سلفاً أن يلقيا كلمة. ولأنه قد سنحت له الفرصة كي يشرد عن ديباجته المعتادة التي كانت تطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني، فإن عرفات ألقى في الواقع كلمات دافئة عن أهمية السلام مع (أبناء العم) اليهود. وجاء رد رابين بالأسلوب نفسه، إذ نوه إلى أن اليهود لم يشتهروا بقدراتهم الرياضية، إلا عندما وصل الأمر إلى نقطة إلقاء الخطب، وهي النقطة التي أثبت فيها أنهم (أي اليهود) أبطال أولمبيون. واستدار رابين نحو عرفات وقال: (يبدو لي، سيدي الرئيس، أنك قد تكون يهودياً بعض الشيء!). عندها ضحك الحضور وارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي عرفات اللتين كانتا ناتئتين عادة ثم رد معلناً: (نعم، نعم. إن راشيل هي خالتي). لكن اللغز هو كيف، بالضبط، استنتج عرفات أن له صلة قرابة بتلك الشخصية التوراتية، وهو اللغز الذي بدا مثل أشياء أخرى كثيرة كانت تتعلق بذلك الرجل الغريب؟ لكن كان من الدلالة الرمزية المهمة بالنسبة إلى تلك المناسبة أن شخصاً (عرفات) كان يفتخر بأنه زعيم من زعماء العالم الإسلامي قد اختار أن يزعم على الملأ أنه ينتمي إلى أسلاف يهود”.
ويشير إنديك إلى أنه “للمرة الأولى، تحدث رابين (في تلك المناسبة) عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقد بدا ذلك الأمر غريباً – إذ باتت مسألة إقامة الدولة حقاً فلسطينياً مقبولاً – لأن رابين كان قد عارض قيام دولة فلسطينية، وأصر على ألا تأتي اتفاقية أوسلو على ذكر ذلك الأمر بأي شكل من الأشكال، لكن كلامه في تلك الليلة كان شيئاً مختلفاً. فبعد أن شعر بأن الفلسطينيين قد ألزموا أنفسهم بالعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، فإن رابين كشف عن رؤيته المتعلقة بسلام يكون فيه للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم. ومضى رابين شارحاً أن المطلوب لتحقيق ذلك هو (الفصل، ليس من منطلق الكراهية، بل من منطلق الاحترام). لكن بعد ذلك بخمسة أسابيع، انتهى المطاف باسحاق رابين ميتاً في غرفة الطوارئ بمستشفى إيشيلوف في تل أبيب، وذلك بعد أن قتله متطرف يهودي. وهكذا فإن عملية اغتيال المهندس الإسرائيلي الرئيسي لعملية صنع السلام وضعت الإسرائيليين والفلسطينيين على طريق من الدمار الذي اكتنف عملية السلام برمتها في نهاية المطاف. ورغم المحاولات التي قام بها الرئيس كلينتون بعد رحيل رابين، فإنه لم يستطع أن ينتشل عملية السلام”.
محاولات كلينتون
ويذكر إنديك: “لقد كان شوطاً طويلاً ذلك الذي قطعناه خلال فترة قصيرة. فالرئيس كلينتون، وفريق السلام التابع له – وهو الفريق الذي كنت أنا أحد أعضائه – كان قد دخل البيت الأبيض مفعماً بالتفاؤل. وباعتباره دارساً للتاريخ، فإن كلينتون كان قد فهم أن الأقدار كانت منحازة آنذاك إلى صف إحداث اختراق قد يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وبالتالي إيجاد تراث دائم لفترة رئاسته، لكن ذلك الجهد البطولي قُدر له أن يتحول في النهاية إلى نوع من الهوس الأعمى (لدى كلينتون) باستكمال المهمة التي كان قد بدأها مع صديقه الإسرائيلي الذي تم اغتياله (رابين) وباستعادة بريق رئاسته التي كانت قد بدأت سمعتها تتدهور.
لقد حاول بيل كلينتون أن يغيّر وجه الشرق الأوسط عن طريق إحلال السلام وعن طريق تكريس طاقاته ومكانته في سبيل هدف كان متوافقاً تماماً مع روح المثالية والتفاؤلية التي تشكل أساساً للسياسة الخارجية الأميركية، وسعى كلينتون إلى تحويل مناطق نائية غارقة في الصراعات والنزاعات القبلية إلى أرض سلام وتناغم. وعلى النقيض من خلفه جورج دبليو بوش، فإن كلينتون اختار أن يعمل في داخل الحدود الرسمية التقليدية، مفضلاً استخدام أدوات الديبلوماسية على استخدام أسلحة الحرب، وذلك في إطار سعيه إلى جر منطقة الشرق الأوسط عبر عتبة القرن الحادي والعشرين”.
ويلفت إنديك إلى أن “الرئيس كلينتون لم يكن غافلاً عن الشرور والآفات التي كانت تكتنف منطقة الشرق الأوسط آنذاك، فلقد كان هناك وحش مفترس عنيف يدبر انتقامه في بغداد، وملالي ثوريون في طهران يستخدمون الإرهاب والعنف لنشر أيديولوجيتهم الإسلامية إلى بقية إرجاء منطقة الشرق الأوسط، وساسة إسرائيليون يتصارعون من أجل البقاء في عالم سياسة التحالفات القاسي، وأنظمة عربية فاسدة أخفقت في تلبية متطلبات شعوبها ولم تسمح لها بأي مجال سياسي كي تعبر عن سخطها، لكن كلينتون اختار أن يحوي ويحصر آثار تلك التأثيرات السلبية كلها بدلاً من أن يجابهها، وذلك من منطلق اعتقاده بأن تحقيق اختراق على صعيد عملية السلام سيسهم في تغيير تلك الأمور كلها أكثر من أي شيء آخر، ولم يتجاهل كلينتون رغبة أميركا الشديدة في أن تنشر الديموقراطية في الخارج، لكنه كان يؤمن بأن صنع السلام كان بمثابة العنصر المحفز والمنشط لإطلاق عنان إمكانات المنطقة على صعيد التحررين السياسي والاقتصادي”.
ويؤكد إنديك أن “الرئيس كلينتون حقق بعض النجاحات المهمة فلقد تم تحييد التأثيرات السلبية الناجمة عن العراق وإيران، كما تم تعزيز أمن دول الخليج الغنية بالنفط، وهي الدول الحليفة لأميركا. ونجح كلينتون في التوسط نحو إتمام اتفاقية سلام بين إسرائيل والأردن، مستفيداً في ذلك من احترافية إسحق رابين والملك حسين كرجلي دولة. وعلاوة على ذلك، فإن الرئيس كلينتون نجح في أن يجلب المفاوضات الإسرائيلية – السورية إلى التي لم يكن بين الطرفين وبين التوصل إلى اتفاق عندها سوى الموافقة على التخلي عن نحو 200 متر على امتداد الساحل الشمالي لبحيرة طبرية، وبالنسبة إلى اتفاقيات أوسلو، التي كان قد تم التفاوض في شأنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين من وراء ظهره، فإنه (كلينتون) التقطها ونجح ببراعة في ترجمتها إلى سلسلة من المعاهدات والمعايير المرحلية الرامية إلى تحقيق سلام دائم كان من الممكن له أن يضع نهاية للصراع الذي استمر على مدى عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن بدلاً من التوصل إلى السلام، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين انخرطوا بعد ذلك في دائرة مغلقة من الصراع الدموي الذي نجح على مدى الأعوام الخمسة اللاحقة في تدمير إطار الكياسة الذي كان قد استغرق بناؤه عقوداً ثلاثة من الديبلوماسية الأميركية المتفانية. ومع اقتراب فترة رئاسة كلينتون الثانية من نهايتها، كانت منطقة الشرق الأوسط قد بدأت فعلياً في الانتكاس إلى ميولها الأصولية والقبلية العنيفة، وهو الاتجاه الذي اندلع في غزة والضفة الغربية، لكنه عبر عن نفسه بأعنف طريقة من خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر”.
ويعتبر إنديك أنه “بعد رحيل كلينتون، اختار خليفته (جورج دبليو بوش) أن يهجر (صنع السلام) إلى (صنع الحرب) من منطلق اعتقاده بأن ذلك سيوجد دافعاً أكثر فاعلية لإحداث التحوّل في منطقة الشرق الأوسط. والواقع أن هذا الأمر يعتبر قصة مليئة بالتناقضات المثيرة للسخرية، فالرئيس كلينتون وفريقه كانوا يؤمنون بأنهم منخرطون في جهد نبيل يهدف إلى إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط على غرار النموذج الأميركي، لكن أفضل جهودهم لم تكن كافية لتنفيذ تلك المهمة فجاءت العواقب على عكس الأهداف التي كانت مرجوة”.
ويقول: “لقد أعدت سرد تفاصيل تلك المأساة (في سياق الكتاب) في أجزاء ثلاثة. ففي الجزء الأول، يستخدم الرئيس كلينتون طاقاته الديبلوماسية كي يصل إلى الذروة، ألا وهي تلك اللحظة في العام 1995 عندما بدا الأمر فعلياً وكأن وادي السلام يفتح أبوابه أمامنا. وفي سبيل الوصول إلى تلك النقطة كان الرئيس كلينتون قد طوّر استراتيجية جمعت بين السعي إلى السلام وبين سياسة (الاحتواء المزدوج) في سبيل التعامل مع الأنظمة الشرق أوسطية (المارقة) في العراق وإيران. أما الجزء الثاني فإنه يستعرض تفاصيل مصير سياسة (الاحتواء المزدوج) التي كانت بمثابة الفرع الآخر لاستراتيجيتنا، مع التأكيد، خصوصاً، على العلاقة التكافلية بين التطورات في منطقة الخليج وبين مصير استراتيجية كلينتون الأولية الخاصة بصنع السلام في الحلبة العربية – الإسرائيلية.
وبالنسبة إلى الجزء الثالث من الكتاب فإنه يقدم عرضاً تاريخياً تسلسلياً للدوامة النزولية التي بدأت باغتيال إسحق رابين، ثم وصلت إلى ذروتها عندما رفض ياسر عرفات المعايير التي وضعها بيل كلينتون في سبيل التوصل إلى تسوية نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأيام الأخيرة من فترة رئاسته والواقع أن الكيفية التي وصلنا بها إلى تلك النقطة، مروراً بـ شيبرر ذي تاون وجنيف وكامب ديفيد هي قصة دراماتيكية في حد ذاتها. لكن الأمر الأهم من ذلك هو تلك الدروس التي يمكننا أن نتعلمها من تلك المحاولة الشجاعة – وإن كانت غير ناجحة – في سبيل التوصل إلى تحقيق الهدف المتمثل في وضع نهاية شاملة للصراع العربي – الإسرائيلي”.
ويضيف: “ان الإخفاق الذي منيت به جهود الرئيس كلينتون في النهاية كان أمراً شخصياً جداً بالنسبة إلي. فلم يكن بوسعي مطلقاً أن أتخيل عندما وصلت مع زوجتي جيل وابنتي سارة إلى أميركا في العام 1982 – كأستاذ زائر من أستراليا إلى جامعة كولومبيا – أنني سأنضم بعد مرور أعوام عشرة على ذلك إلى طاقم موظفي البيت الأبيض وأن أصبح مسؤولاً عن المساهمة في صياغة استراتيجية الرئيس كلينتون إزاء منطقة الشرق الأوسط بصفتي مساعده الشخصي في مجلس الأمن القومي، فقبل 20 عاماً على وصولي إلى أميركا، وعندما كنت طالباً في الجامعة العبرية في القدس، كنت قد علقت فجأة هناك عندما اندلعت حرب يوم الغفران في العام 1973 كانت تلك لحظة حاسمة وفارقة في حياتي. فبينما كنت أبقى مستيقظاً بالليل للاستماع إلى بث محطة (بي بي سي) الإذاعي عن جهود هنري كيسنجر للتفاوض في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أدركت آنذاك مدى الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الذي يستطيع من خلال ديبلوماسيته أن يساهم في إيجاد حل للصراع العربي – الإسرائيلي. ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، أصبحت شديد الاهتمام والولع بالدور الأميركي في دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إذ دأبت على دراسة ذلك الجانب والكتابة عنه وتدريسه للطلاب. ثم حصل فجأة بعد ذلك أن وجدت نفسي في مركز ذلك الجهد عندما انضممت إلى إدارة كلينتون.
وحتى في ذلك الحين لم يكن بوسعي أن أتخيل أنني سأصبح بعد مرور عامين أول سفير يهودي لأميركا لدى إسرائيل، وذلك عندما ابتعثني الرئيس كلينتون ووزير خارجيته وارين كريستوفر كي أعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين على محاولة اتمام اتفاق السلام الذي كان مستهدفاً آنذاك بين إسرائيل وسورية. وبعد ذلك بعامين، عينتني وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت كأول يهودي في منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وكنت مسؤولاً (بموجب ذلك المنصب) عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الرئيس كلينتون إزاء العالم العربي. وفي يوليو من العام 1999 وخلال أول زيارة قام بها إلى واشنطن بصفته رئيساً لوزراء إسرائيل، طلب إيهود باراك من الرئيس كلينتون أن يبتعثني مرة ثانية كسفير لأميركا لدى إسرائيل كي أعمل معه على التوصل إلى نهاية شاملة للصراع العربي – الإسرائيلي، وهو الهدف الذي كانا قد حدداه كهدف مشترك لهما.
إن عملية صعود ذلك (الجبل) بدت طبيعية ومقدرة إلى درجة أنني لم أفكر مطلقاً في النظر إلى الأسفل لأتأمل مدى سهولة إمكانية سقوطنا من علٍ. وعلى غرار ما حصل لشخصية إيكاروس الأسطورية، فإنني لم أبدأ في إدراك مدى خطورة المسألة برمتها إلا عندما ذاب (الشمع) من على جناحي في النهاية”.
ويتابع إنديك: “إن ذلك الحس المفعم بالحكمة كان ينبغي أن يبدأ بعد مرور شهور خمسة على وصولي إلى إسرائيل، وتحديداً في الليلة التي اغتيل فيها إسحق رابين، إذ كنت في جناح الطوارئ بمستشفى إيشيلوف مع ليا رابين (أرملة إسحق رابين) في تلك الليلة المصيرية، تماماً مثلما كنت محظوظاً بوجودي مع الرئيس كلينتون خلال كل لقاء عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المغتال (رابين) لكنني أقنعت نفسي بأن قرارات رابين كانت قد دفعت عملية السلام إلى نقطة غير قابلة للانتكاس. وحتى الهزيمة الانتخابية التي مني بها شمعون بيريز بعد شهور سبعة… لم تؤثر كثيراً على قناعتي تلك. لكن ما حصل هو أن حقبة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو أصبحت بمثابة الشتاء بالنسبة إلى عملية السلام، وذلك في الوقت الذي صارعنا فيه من أجل التفاوض في شأن اتفاقيتي (الخليل) و(واي ريفر) وتقوية قفص احتواء صدام حسين، وملاحقة نوع من الانخراط السرابي مع إيران”.
الانتفاضة لا السلام
ويستطرد إنديك: “تماماً مثلما أن دفء فصل الربيع يمحو سريعاً ذكريات برودة الشتاء، كذلك كانت الحال عندما أدى انتخاب إيهود باراك إلى إعادة إحياء إيماني بالمصير الواضح لدى عودتي إلى إسرائيل من أجل فرصة ثانية لإتمام الاتفاق. لكنني لم أبدأ في إدراك حجم التأثير الحقيقي لاغتيال رابين ومدى انعكاسات عدم قدرتنا على إتمام اتفاقات السلام خلال الأعوام الأخيرة من فترة الرئيس كلينتون إلا عندما تم ابتعاثي إلى إسرائيل كسفير خاص للرئيس جورج دبليو بوش حيث عملت مع آرييل شارون الذي كان قد تم انتخابه حديثاً آنذاك كرئيس لوزراء إسرائيل. ولأنني كنت منخرطاً عن كثب في جهود صنع السلام التي بذلها الرئيس كلينتون وفي استراتيجيته الأوسع المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، فإنني كنت ومازلت أشعر بنوع من المسؤولية الشخصية، ليس أقله إزاء فهم وتفسير الأشياء التي جنحت نحو الخطأ من منظور شخص مطلع على بواطن الأمور. وعلى امتداد المسيرة، توصلت إلى إدراك مفاده أن النوايا الطيبة المدعومة بالنفوذ الأميركي الهائل ليست كافية لوحدها لإنجاز المهمة الصعبة المتعلقة بتشكيل مسار تاريخ منطقة الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فإن المرء يحتاج إلى أن يتخيل العواقب الممكنة التي تقبع وراء النتائج التي كنا نأملها. وفي واقع الأمر فإن الأمل والتفاؤل هما عنصران حاسمان من عناصر البراءة التي تعد بمثابة السمة المميزة لانخراط الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. فلماذا نتحمل عناء محاولة تغيير مثل تلك المنطقة المضطربة إلا إذا كنا مؤمنين على نحو ما بأننا نستطيع القيام بذلك، وبأنه يجب علينا القيام بذلك؟. لكن الجانب المظلم من تلك البراءة هو نوع من السذاجة الناجمة عن الجهل والعجرفة اللذين يفرزان عجزاً مزمناً عن فهم المفارقات المتعددة الكامنة في منطقة الشرق الأوسط. فلقد حاول الرئيس بيل كلينتون أن يصنع سلاماً شاملاً في تلك المنطقة، لكنه لم يحصل في نهاية المطاف سوى على الانتفاضة (الفلسطينية). أما الرئيس جورج دبليو بوش فإنه حاول أن يجعل الشرق الأوسط ديموقراطياً، لكن فلننظر إلى النتيجة التي وصلت اليها الأمور الآن”.
ويوضح إنديك: “بالطبع لم يكن لدى الرئيس بوش نية لاتباع خطوات كلينتون. لقد كان مقتنعاً بأن بإمكانه تحقيق أفضل وذلك عن طريق انتهاج طريق معاكس. ومن منظور تحقيق الديموقراطية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خطا بوش خطواته خارج الحدود التقليدية المتبعة في العرف السياسي وتخطى ببراعة تلك المخاوف الأميركية العتيقة تجاه مسألة الاستقرار في منطقة ساخنة تحوي مصالح حيوية على أراضيها. وكما فعل كلينتون، حقق بوش بعض النجاح في طريقه، أطاح بصدام حسين – الذي كان من الممارسين الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط لكن بأساليب العنف – وضغط على بشار الأسد لإنهاء الاحتلال السوري للبنان طوال 30 عاماً. لكن التبعات غير المقصودة لطموح بوش من وجهة النظر العادية هي حال الفوضى والانقسام الطائفي في العراق، حال الشلل والتوتر المتزايد الذي أصاب لبنان، الرغبة الإيرانية للاستحواذ على العالم العربي مدعومة بنهجها الجريء لامتلاك قوة نووية، والانقسام السني – الشيعي الذي بدأ يسري في المنطقة. وامتلأ الفراغ السياسي الذي ساعد بوش على خلقه بالجماعات الإسلامية المسلحة، خصوصاً (حزب الله) في لبنان وحركة (حماس) في غزة وكلتا الحركتين ترفضان حق إسرائيل في الوجود. إذاً ما الذي يجعل زعماء الولايات المتحدة يشعرون بهذا التصميم الإيجابي لتغيير وضع الأسواق والأزقة الخلفية للشرق الأوسط؟ وما الذي خلف منطقة الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي تؤخرهم وتقدمهم وتشدهم إلى مستنقعاتها؟ إن هدفي هنا (في الكتاب) الإجابة عن تلك الاسئلة وبلورتها من خلال خبرتي التي اكتسبتها في أعوام حكم كلينتون”.
ويرى إنديك أنه “بتحليل النجاحات والفشل الحاصل في ديبلوماسية كلينتون في الشرق الأوسط وعن طريق فحص ما جرى عندما التقت ثقافات الأميركيين والشرق أوسطيين وقيمهم وقوتهم على أرض المعركة السياسية، فإن هدفي هنا هو تقديم شرح لتوضيح السبب الذي يجعل هذه المنطقة شديدة المقاومة للتغيير التحولي الذي تحرص عليه أميركا للتطوير، وهذا الفهم الخاص له تطبيقات عملية تجاه أي جهود مستقبلية. فمن ناحية أولى، كان استخدام كلينتون للأسلوب السياسي التقليدي غير متناسب مع مهمة التحول، لأن ذلك كان يعني بأن عليه العمل ضمن الإطار الشرق أوسطي الموجود فعلياً. وفي المرات النادرة، التي اختار القادة العرب والإسرائيليون فيها الخروج عن هذا الإطار، تمكن كلينتون من تحقيق انطلاقات ناجحة. لكن في غالب الأحيان كان لزاماً عليه العمل مع قادة عرب يشلهم افتقادهم للشرعية، أو منشغلين بالحفاظ على بقائهم في الحكم بدلاً من تحقيق الرخاء لشعوبهم، فيما قادة إسرائيل المنتخبون مقيدون بالإملاءات السياسية لفصائل التحالف الحكومي ومقيدون أيضاً بالرأي العام المتشكك، وكان ذلك هو جوهر المشكلة، بالإضافة إلى الخطوات الخاطئة لكلينتون وفريقه للسلام. ومن ناحية أخرى – رغم ذلك – كانت الخلاصة التي انتهى إليها الرئيس بوش هي أن الطريق الوحيد لإحداث التحوّل يكون بتغيير نظام الحكم – وكان هذا خطأ أكثر شناعة من أخطاء كلينتون كلها. فنظام الشرق الأوسط الجديد لا يمكن تحقيقه فقط بالإطاحة بواحد من أكثر قادته فظاعة. ومسألة الإعداد لحرب ربما تعيد تشكيل السياق الاستراتيجي، وبالتالي توجد فرص أمام الولايات المتحدة لمحاولة فرض التحوّل الذي يبدو أننا ملزمون بالسعي إلى تحقيقه. لكن ينبغي اللجوء إلى استخدام ديبلوماسية أميركية ذكية ومنظمة جيداً لاستغلال تلك الفرص، كما تعلمها بوش بطريقة شاقة. وخلال تلك العملية السلمية بدت وكأن جميع الآمال لإيصال الصراع العربي – الإسرائيلي إلى تسوية تفاوضية قد ذهبت هباء. وتلك الأعوام التي تعج بالمواجهات الدموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين – فيما بوش يحاضر عند كلا الجانبين – لم تؤدِ إلا إلى عكس ما تنشده العملية السلمية التي انتصر فيها رابين وأصر كلينتون على انتهاجها. وبدلاً من (الفصل من منطلق الحفاظ على الاحترام) الذي تصوره رابين، كان الإسرائيليون والفلسطينيون ينفصلون عن بعضهم بسبب الكراهية التي ظن أنها تنزوي”.
أولوية السلام
ويلفت إنديك إلى أنه “ينبغي على الإدارات الأميركية المقبلة تكريس جزء كبير من طاقتها لترميم وإصلاح سياسة إدارة بوش التي خلّفت حرباً خطيرة ومكلفة، كما أن إحلال السلام يجب أن يكون كذلك من الأولويات العاجلة للإدارات المقبلة بعد أعوام سبعة من الإهمال دفعت نحو هذه الحال من التدهور لدرجة أن فرص إحلال السلام وصلت عند منعطف خطير وأتباع سياسة التسوية العربية – الإسرائيلية – كما تثبت تجربة كلينتون – ربما يكون لها تأثير واسع وإيجابي بطول منطقة الشرق الأوسط، ولو تبنى الرؤساء الأميركيون القادمون تلك السياسة السلمية، فربما ستتقدم التسوية كثيراً لتمحو الآثار السلبية التي تسبب فيها بوش. وستعتمد نجاح تلك الجهود، إلى حد كبير، إلى إحياء الديبلوماسية الأميركية التي أُهملت غالبية العقد الماضي. وقد أثبتت تجربة العراق محدودية نتائج استخدام القوة إضافة إلى إرهاق المؤسسة العسكرية الأميركية إلى حد كبير، كما أدى التراجع الأميركي وانتقال الثروة بشكل واسع إلى الدول المنتجة للنفط إلى تقليل النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة وترك شعبها قلقاً حيال التزامات جديدة هذا الأمر ألقى على الديبلوماسية مهمة ردم الهوة بين المصالح الأميركية وطموحاتها والوسائل المتاحة لحماية هذه المصالح وتنميتها. لهذا ينبغي التركيز على التعاون مع الحلفاء وبناء التكتلات وحل النزاعات – وهي مهمات ديبلوماسية – بحيث تتغلب على الإصرار المتغطرس لأتباع الطريقة الأميركية التقليدية. وخلال مدة بوش الثانية فهمت وزيرة خارجيته هذه الحقيقة فبدأت بترميم العلاقات العابرة للأطلسي وأعادت بناء العملية السلمية العربية – الإسرائيلية وبدأت التفاوض مع كوريا الشمالية وإيران على برامجهما النووية. حتى جورج دبليو بوش نفسه، بعد انتقاده جهود كلينتون للتسوية السلمية، عقد مؤتمر للسلام بين العرب والإسرائيليين في أنابوليس بولاية ميريلاند في نوفمبر 2007 لإعادة إطلاق المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ويختم إنديك مقدمته: “ان الجهود الديبلوماسية الحثيثة التي بذلتها إدارة كلينتون في الشرق الأوسط يمكن الاستنارة بها في التقدم على هذا المسار، والدروس المذكورة هنا تشير إلى استراتيجية أقل اعتماداً على القوة، لكنها تعتمد أكثر على دعم الديبلوماسية مع التهديد بالقوة. كما تشير تلك الدروس إلى مسار يعزز من الميل الأميركي لنشر الديموقراطية مع الحفاظ على الاستقرار. ويجب أن تكون مثل هذه الرؤية أقل سذاجة في افتراضاتها وأكثر تواضعاً في طموحاتها وانتهاجها وأكثر خيالاً في توقع ما يمكن حدوثه من أخطاء. كما تثبت لنا تجربة كلينتون أيضاً بأن الرؤساء القادمين لن يكونوا قادرين على تحقيق الرؤية الأميركية بخصوص بناء شرق أوسط سلمي في غياب قادة يتمتعون بالشجاعة والرؤية الثاقبة وفي إدارة الحكم، أمثال أنور السادات ومناحيم بيغن والملك حسين بن طلال وإسحق رابين. وبالطبع لا يمكن للولايات المتحدة ابتداع مثل هذه الشخصيات، لكن بإمكانها استخدام نفوذها الهائل لتغيير الإطار الاستراتيجي الذي يعمل من خلاله قادة الشرق الأوسط، وبالتالي تؤثر على دوافعهم، ولو برز هؤلاء القادة لاستغلال الفرصة المتاحة، فإن الرؤساء (الأميركيين) القادمين يجب أن يكونوا مستعدين للإمساك بأيديهم الممدودة لإيصالهم إلى بر الأمان. هذا لو طلبوا مساعدة أميركا لكن على أميركا أيضاً أن تكون في أفضل وضع استعداد لها لتحقيق السلام الذي تسعى إليه ويسعى إليه أصحاب الأيدي المضطربة”.
تعلم الدرس
يستهل إيثان برونر، رئيس مكتب جريدة “نيويورك تايمز” في القدس، عرضه لكتاب إنديك بمقولة مشهورة عن أسامة بن لادن مقولة، وهي: “أنتم الأميركيون لديكم الساعات لكننا العرب لدينا الوقت”، معتبراً أن “هذا الدرس تعلمه مارتن إنديك جيداً، ورغم هذا الدرس القاسي الذي أخر صدور ذكريات الأعوام التي قضاها كمسؤول كبير في إدارة كلينتون وسفير لإسرائيل محاولاً المساعدة في تغيير الأوضاع المؤلمة التي تحملها في الشرق الأوسط، وربما يجد كثير من القراء هذا الكتاب مفصلاً بدرجة مطولة، إلا أنه بالنسبة إلى من تستهويهم معرفة تفاصيل ومخارج ومداخل المنطقة وكيفية صياغة خطوات السياسة الأميركية فإن هذا الكتاب يستحق القراءة فهو واقعي ويحمل نقداً ذاتياً وإضافة لما سبق، إذ إنه مكتوب بطريقة محبوكة”.
ويشير برونر إلى أن “غالبية كتاب مارتن إنديك يقدم لنا تفسيراً مفصلاً عن الأخطاء التي برزت على المسار الفلسطيني في الضفة الغربية، ومع السوريين ومع العراق، إذ تمكن إنديك بتحليله لهذه الأخطاء من تقديم نظرة عميقة تظهر علاقات أميركا بسائر دول الشرق الأوسط. ورغم أنه ليس أول من يقدم هذا التفسير – وليس آخر من يقدمه، إلا أننا نجد بأن زملاءه في طاقم الخارجية الأميركية والمختصين في شؤون السلام – أمثال دينيس روس ودانييل كيرتزر وآرون ميلر – نشروا كتباً عن هذا الموضوع، حتى كلينتون نفسه أوردها في مذكراته كذلك عدد المسؤولين والصحافيين الإسرائيليين والأجانب. لكن المميز في كتاب إنديك أنه يكشف أموراً جديدة عن المفاوضات التي شهدت نزاعاً، وأيضاً عن الأفراد، لكن الصورة العامة تبقى من دون تغيير. كما تميز إنديك في كتابه بنبرته التحليلية أكثر مما حاول سابقوه وقدّم مجموعة من الدروس تعلمها بالخبرة الشاقة، وكانت هذه الطريقة ناجحة إلى حد ما لأنه عرضها من جانبين: أين فشلنا؟ وكيف يمكن أن نحقق نتيجة أفضل في المرة المقبلة؟ وفي ما حالات الفشل عميقة ومؤثرة فإن النصيحة الموجهة إلى إدارة أوباما المقبلة تبدو ضبابية إلى حد ما. فيرى إنديك – مثلاً – أن كلينتون لم يدرك أن دفعه سورية لعقد محادثات سلام مع إسرائيل، سيجعل الأردن والفلسطينيين يطلبون بأن يذهبوا هم أولاً إلى هناك حتى قبل بدء هذه المحادثات، وكانت النتيجة فشل المحادثات السورية. وحتى إدارة الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس لم يفهما ذلك، بل ركزا على موضوعي كوريا الشمالية والفلسطينيين وساعدا – من دون قصد – على إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية السورية، وفي الوقت نفسه، لم ترد واشنطن أن تتفاوض إسرائيل مع سورية لأنها كانت تحاول عزل سورية وقتها”.
ويلفت برونر إلى أن “إنديك يرى في كتابه، أيضاً، أن كل شيء في تلك المنطقة مرتبط بالآخر في إجابته عن سؤال مثل: ما الذي يمكن فعله حيال أي تطورات غير متوقعة؟ بمعنى هل ستدفع مسيرة السلام الإسرائيلي – الفلسطيني حكومات عربية – مثل مصر والسعودية – لبذل جهودها لكبح جماح الطموح الإيراني النووي. وفيما ترى الولايات المتحدة أن جميع النزاعات الدائرة (بين الأطراف ذات العلاقة) تتمحور على كيفية التقليل من التأثير الإيراني، خصوصاً بعد أن قامت الولايات المتحدة من دون قصد بتعزيز وضع إيران بعد أن هاجمت ألد أعدائها، وهما حركة (طالبان) وصدام حسين، الآن نرى أن أميركا في وضع استعداد لمواجهة دولة على وشك بناء ترسانة نووية لها تملك تأثيراً قوياً على سورية والعراق ولبنان والفلسطينيين. لهذا فإن الهدف المركزي لواشنطن الآن هو نزع أنياب إيران وإنهاء حال الصراع مع إسرائيل. وهذا الهدف سوف يساعد كثيراً من وتيرة التقدم في هذا المسار.
ولذلك ينظر إنديك إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مناخاً سياسياً فريدا وصعباً، أيضاً، بالنسبة إلى الولايات المتحدة بسبب المقاومة التي يبديها القادة العرب تجاه حركة التغيير، وبسبب عناد السياسات الإسرائيلية، والخلل المزمن في وظيفة القيادة الفلسطينية وتعرض أي عملية سياسية للإرهاب. وهو بذلك يطالب إدارة أوباما بأن تجعل أهدافا أكثر تواضعاً، وفرضياتها أكثر واقعية من تلك التي وضعتها إدارة الرئيس بوش، وهي السلام والديموقراطية في كل مكان. ولم يفت إنديك أن يذكر في كتابه أنه ساهم في الجهود المبذولة لدفع هذه العملية عندما قدّم اقتراحات – غالبها حكيم وعميق – لكنها أيضاً تعتمد على الأمل أكثر من الخبرة في ما يتعلق بكيفية وضع حل لبناء دولتين”.
تفسير من الداخل
هذا العرض لبرونر في “النيويورك تايمز” يقابله عرض آخر في “مجلة العلاقات الخارجية” (الفورين أفير) أعده كارل براون الذي يرى أن كتاب إنديك بمثابة تفسير كتابي “حميم” أو بوصف دقيق جداً، فإن هذا الكتاب “أكثر من مجرد تأريخ لديبلوماسية السلام وتأريخ لاتفاقيات أُبرمت واتفاقيات فوتت في أعقاب حرب خلفت وراءها حلاً غير مرتب مع تحركات خفية انحرفت عن مسارها المرسوم، وذلك كله في سياق تعريف لدور القوى العظمى الوحيدة بعد انتهاء الحرب الباردة وداخل منطقة الشرق الأوسط”.
ويذكر براون أن “اسم كتاب إنديك المقتبس من رواية الروائي الأميركي مارك توين (أبرياء في الخارج) يظهر الأميركيين – كما يؤكد إنديك – على أنهم أبرياء يسعون إلى إحداث تغيير في منطقة الشرق الأوسط من المنظور الأميركي، وهذا التوجه يولد اضطراباً ساذجاً في السياسة الأميركية عند تعاملها مع موضوع الشرق الأوسط. وجزء من هذا التوجه سببه السذاجة، وجزء منه سببه الجهل وجزء منه سببه الغطرسة. لكن تفسير إنديك لا يظهر حقيقة هيمنة السذاجة أو الجهل، بل الغطرسة التي تمثل ببساطة السلوك الطبيعي للقوى العظمى عند تعاملها مع دول أقل شأناً، ومع ذلك فهناك دروس مختلفة يمكن تعلمها من (أبرياء في الخارج) بعض هذه الدروس أكد عليها المؤلف وأما الدروس الأخرى فيمكن استنباطها من القراءة المتأنية للكتاب”.
ويقول براون: “إن إنديك عندما ذهب إلى الولايات المتحدة أوائل الثمانينات عمل لبعض الوقت كباحث في لجنة العلاقات العامة الأميركية – الإسرائيلية (أيباك) والتي تعتبر نفسها (اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل)، بعدها ترك أنديك هذه المنظمةليؤسس (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى) وهو مركز دراسات بحثية ترأسه أنديك لمدة أعوام سبعة، ومن موقعه هذا اختير ليكون ضمن فريق إدارة الرئيس كلينتون، إذ عمل أولاً كمسؤول رئيسي متخصص بسياسات الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، ثم شغل بعدها منصب السفير الأميركي لدى إسرائيل مرتين (من أبريل العام 1995 حتى سبتمبر 1997، ومن يناير 2000 حتى يوليو 2001) وشغل بين هاتين الفترتين منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وبعد عرض خلفية وتاريخ إنديك في (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، والذي يُنظر إليه على أنه مؤيد لإسرائيل، وبالتالي معادٍ للعرب (الوصف الأول ينطبق بدرجة كافية ولكن الثاني ليس بالضرورة مطابقاً) فهل كان تعيينه في هذا المنصب مناسباً؟ وهذا ما يمكن قوله كله (رغم أن هذا السؤال لن يكون كافياً لأي شخص) فقد كان يعمل في مؤسسة أبحاث ودراسات وليس (لوبي)، ومراكز الأبحاث هذه تضم جميع الأطياف السياسية. إنديك لم يكن مرشحاً بدرجة كافية لتولي المنصب، لكن يبدو أن إدارة الرئيس كلينتون أُعجبت بسيرته الذاتية وعجلت عملية منحه الجنسية الأميركية ووضعت الأمور بتصرفه. وإنديك – على أي حال – كان صريحاً في ما يخص ارتباطه بإسرائيل، وهو ارتباط يراه وثيق الصلة بالسياسة الأميركية، وقد أيد إنديك جهود إدارة كلينتون لبدء تسوية عادلة وتفاوضية بين إسرائيل وجيرانها”.
ويضيف: “يعالج كتاب (أبرياء في الخارج) أهم التطورات التي طرأت على السياسة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أثناء فترة رئاسة الرئيس كلينتون. كما يناقش الكتاب افتتاح سياسة (الاحتواء المزدوج) وعواقبها، والتي أعلن عنها انديك بنفسه في مايو 1993، وذلك في اجتماع لـ(معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى). ذلك البيان السياسي – الرافض لسياسات توازن القوى، والذي تضمن احتواء الولايات المتحدة لكل من إيران والعراق، معتبراً أن نظام حكم صدام حسين لم يكن هناك من سبيل لإصلاحه. ويروي إنديك أيضاً أن أول محاولة كانت تبدأ بسياسة (سورية أولاً) وبذلك أعطت أولوية للسعي إلى تسوية إسرائيلية مع سورية بدلاً من تسوية مع الفلسطينيين، ولكن (اتفاق أوسلو) بين إسرائيل والفلسطينيين انحرف عن هذا المسار وعكس الأولويات المرسومة. ثم يمضي المؤلف لإبراز جهود أميركا المحبطة لتطويق صدام عن طريق هدف مطلق وهو للإطاحة به، ومن بين هذه الجهود كان هناك تحرك سري لم يكتب له النجاح في العام 1995 تلته عملية (ثعلب الصحراء) في ديسمبر من العام 1998 وتلك العملية الأخيرة تضمنت هجمات جوية أميركية شنت ضد العراق لمدة أيام أربعة بعد عرقلة صدام مرة أخرى لعمل فريق مفتشي الاسلحة التابع للأمم المتحدة عند قيامهم بمهام مراقبة أسلحته. وفي الوقت نفسه، فإن جهود تحقيق انطلاقة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران (قبل وأثناء فترة رئاسة الرئيس الإيراني الإصلاحي محمد خاتمي) قد باءت بالفشل خصوصاً بعد تحرك النائب في الكونغرس الأميركي نيوت غينغريتش الذي قاد تحركاً للمصادقة على قرار فرض عقوبات ضد كل من إيران وليبيا العام 1996، وأخيراً كتب إنديك عن المحاولة الثانية لدفع تسوية بين الإسرائيليين والسوريين، وهذه باءت أيضاً بالفشل في أوائل العام 2000، تلاها تلك المفاوضات الدراماتيكية التي دفعها كلينتون خلال النصف الأول من العام 2000، والتي أوشكت على تحقيق تفاوض وتسوية كبيرة بين إسرائيل والفلسطينيين في كامب ديفيد”. ويتابع براون: “ان إنديك تتبع أحداث الأعوام الثمانية لإدارة كلينتون من خلال تحركات مجموعة أفراد كانوا مسؤولين عن رسم وتفعيل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما تحدث عن أحداث غيرت مجرى تلك السياسة لم تكن في الحسبان، مثل المذبحة التي ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها مسلمين أثناء تأديتهم للصلاة في العام 1994، ومقتل زوج ابنة صدام حسين – حسين كامل – بعد عودته من الأردن العام 1995 واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في العام نفسه. ولم يخل الكتاب أيضاً من اللمسات الساخرة، مثل الجهود المضنية التي بذلها الرئيس كلينتون وفريقه قبل اجتماع جرى في البيت الأبيض في سبتمبر العام 1993 بين رابين وعرفات للتأكد من أن عرفات لن يقبل الرئيس في المراسم العلنية لافتتاح عملية أوسلو للسلام.
وعموماً، فإن إنديك – كونه لعب دوراً في فريق كلينتون – قدم أكثر ثناء إيجابي ممكن لسياسة كلينتون في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه انتقد بعض الجوانب في أداء إدارة كلينتون بما فيه أداء كلينتون نفسه، كما حاول إنديك من خلال الكتاب تلميع سجل كلينتون في مواجهة الأعوام الثمانية التي قضاها بوش في الرئاسة، وبالطبع كان من الأسهل على إنديك إظهار إدارة كلينتون بشكل أفضل من خلال كتاب ألف العام 2008 بدلاً من كتابته قبل أعوام ثمانية”.
دروس في الديبلوماسية
ويطرح براون سؤالاً: ما الذي يمكن تعلمه من ديبلوماسية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط طوال الأعوام الثمانية التي وضعها وفسرها كتاب “أبرياء في الخارج”؟ فيجيب: “أولاً ان المراكز السياسية التي تقدم من طرف واحد، مثل الاحتواء المزدوج، وما تبعه، من المرجح أنها تولد نوعاً من المقاومة بدلاً من منح امتيازات، وينطبق هذا القول فعلياً عندما تواجه قوة عظمى قوى إقليمية – مثل إيران والعراق – وهي دول لها تاريخ مطول تعتبر فيه نفسها بمثابة مخالب في سياسات القوى العظمى. ثانياً، تصريحات السياسة الخارجية القوية التي تصدر من جانب واحد قد تكون مغرية للقوى السياسية الداخلية الساعية للدخول في سياسات أكثر عدائية. ثالثاً، إن لم تكن مستعداً للتخلص فوراً من خصومك، فإنه من الحكمة أن تترك لهم بعض المجال ليهربوا من غضبك عليهم. وأخيراً إن التحركات السرية تحمل بين طياتها نسبة كبيرة من الفشل، وحتى المحاولات الناجحة تتحول على المدى البعيد إلى أمور غير مرغوب فيها (مثل انقلاب العام 1953 ضد حكومة محمد مصدق الإيرانية)، وهذه الدروس مهمة بعضها ظاهر والآخر ضمني وسيكون لها مغزاها العميق مع مضي سياسة الولايات المتحدة قدماً تجاه الشرق الأوسط، وتحديداً مع انتقال الإدارة الأميركية بأمل أن يستفيد من هذه الدروس هذه المرة أصحاب القرار. ونرى – بطريقة ما – أن انتقال الرئاسة من إدارة كلينتون إلى إدارة بوش تعكس في المرآة صورة الانتقال نفسه من بوش إلى باراك أوباما. ففي الصورة الأولى كان الإحساس المسيطر فيها هو الحاجة الملحة إلى اتخاذ تحرك أكثر فعالية لتعويض الأداء الباهت طوال الفترة السابقة. لكن في هذه المرة الموقف معكوس تماماً، فهناك رغبة ملحة لاتخاذ موقف متعقل لإصلاح الضرر الذي ألحقته الخطوات الخاطئة التي تمت طوال أعوام حكم بوش”.