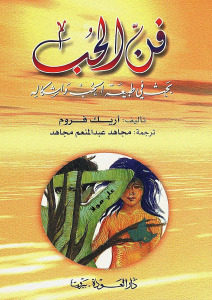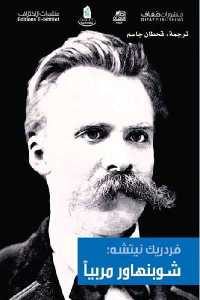كتاب الخطاب العربي المعاصر لـ فادي اسماعيل
 |
كتاب الخطاب العربي المعاصر : قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثةالمؤلف : فادي اسماعيل اللغة : العربية دار النشر : المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة النشر : 1991 عدد الصفحات : 196 نوع الملف : مصور |
وصف الكتاب
الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقديم والحداثة هو في أصله دراسة قدمها الباحث اللبناني فادي إسماعيل إلى الجامعة الأمريكية ببيروت سنة1987 للحصول على درجة الماجستير. وقد تناول فيها بالتحليل نماذج من الخطاب العربي المعاصر في الحقبة التاريخية ما بين1978-1987. يتكون الكتاب من181 صفحة من الحجم المتوسط ويحتوي على تمهيد ومقدمة وأربعة فصول وخاتمة ثم ثبت بقائمة المراجع والكشاف العام.
في تمهيد الكتاب ومقدمته، يحدد الباحث مهمة دراسته على أساس أنها دعوة لعملية قطع تدريجي مع التكوين النظري والمنهجي الذي يتحكم في حركتنا الفكرية والذي هو من مكونات الغلبة الحضارية وسيادة الأنموذج الغربي للمعرفة. ويقرر الباحث أن الأنموذج المعرفي التوحيدي هو الأنموذج القادر -تدريجياً- على القطع مع الأنموذج المعرفي السائد، لأنه الوحيد الذي يفتح آفاق التغيير الكامل، والذي لا يواجه الأنموذج الغربي في جانب لكي يصالحه في جانب آخر. ثم يضيف أنه ليس من هدف دراسته أن تتعالى على واقع التخلف الذي يرزح تحته العالم العربي والإسلامي، وإنما هي مساهمة في وعي التخلف وجهد ناصب نحو العدل الفكري ووضع الأمور في نصابها حتى لا يحمل الفكر التقليدي والقيم السائدة في مجتمعاتنا مسؤولية التخلف والهزائم. ذلك أن الكثير من الجرائم -كما يقرر الباحث- ارتكب في الفكر والواقع من قبل مجتمع النخبة في أقطارنا العربية والإسلامية باسم الحداثة والتقدم والتنمية: تقدم التبعية وتحديث القمع والاستبداد والتسلط وتنمية المسخ والمجتمعات “المفتونة”، وإنه في النهاية قد مررت تحت عباءة التقدم والحداثة والتنمية إجراءات وأفعال هي في النتيجة ضد الحداثة والتنمية والتقدم.
وعن سؤال الأمير شكيب أرسلان: “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” يرى الباحث أن دراسته محاولة متأخرة للإجابة عن هذا السؤال أو بالأحرى عن سؤال مكمل هو: لماذا بعد أكثر من100 سنة من محاولات النهضة والتقدم والتوفيق مع العصر لم نتصالح معه ولم نتقدم؟ إن السؤال القديم: “لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا نحن؟ لم يعد يتحكم بالإشكالية الثقافية الراهنة، بل حل محله سؤال آخر: لماذا لم نتقدم نحن بعد؟ الأمر الذي يجعل من الدراسة محاولة نقدية للخطاب العربي حول الحداثة، وللحداثة بما هي تجربة تاريخية عربية انتهت إلى أن تكون مجرد تطبيق قسري، وتقليد مبتسر، واستهلاك أيديولوجي “للحداثة والتقدم” الغربيين، دون أن يرافق ذلك تحديث للفكر والحريات وللعلاقات والنظم السائدة.
منهجية القراءة
لا يعود الباحث إلى النصوص النهضوية الأصلية، وإنما يحصر قراءته النقدية في الخطاب العربي المعاصر في نماذج مختارة من قراءات المفكرين العرب لمفاهيم وتجارب النهضة والتقدم والحداثة، وتركيب هذه القراءات من خلال ما يبشر به هذا الخطاب من أنموذج مجتمعي ثقافي ينتظم سائر تفرعاته. وليست النماذج الحضارية هنا عند الباحث سوى نموذجين اثنين: النموذج الغربي الأوروبي والنموذج العربي الإسلامي، النموذج الوافد غزواً والنموذج الموروث أصلاً. أما ما اصطلح على تسميته بالأنموذج التوفيقي للتقدم والنهضة فما هو -في رأي الباحث- إلا نظريات لا تقدم سوى حركة ذهنية لدى المثقفين، ليس لها أية تجسيدات حقيقية في أرض الواقع.
وقد أجبر الأنموذج العربي الإسلامي للتقدم على التقهقر والانزواء تاريخياً، وفقد وظيفته التربوية والسياسية والاقتصادية، وانطوى على نفسه متراجعاً إلى خط دفاعي من موقع ثقافة المغلوبين وأيديولوجيتهم. أما الموقف التوفيقي فكان موقفاً مرحلياً انتقائياً وانتقالياً على طريق التغريب والتبعية الشاملة، وبذلك تنتفي أصالته نموذجاً مستقلاً للتقدم والنهضة، بل ما هو في النهاية إلا مساومة على الأصل وتكيف مع النموذج الوافد وتصالح معه. ومن ثم لم يكن الموقف التلفيقي في حقيقته إلا خطوة تاريخية متراجعة لصالح الأنموذج الحضاري الآخر، بوعي من أصحابه أو من دون وعي. بهذا كان التوفيق حركة ذهنية شكلية وقالباً فارغاً يملؤه القادرون على التحكم بحركة الواقع. أما الأنموذج الغربي للتقدم والنهضة فقد أمسى هو المتحكم بالواقع عبر الحضور الأوروبي المباشر في مرحلة الاستعمار، ثم عبر النخب الوطنية القائدة والأيديولوجيا التحديثية في مرحلة ما بعد الاستعمار المباشر، أو ما اصطلح عليه بالاستقلال.
وبناء على هذا التحديد للنماذج الحضارية للتقدم والنهضة، يحدد الكاتب منهجية بحثه في القيام بالأمرين الآتيين:
– قراءة نقدية تفكيكية لثقافة النخبة وأيديولوجيتها والأطروحات النظرية التي تساندها.
– قراءة للثقافة المغلوبة على أمرها ولواقع جماعة المغلوبين، وهي قراءة يريدها الباحث ملتزمة ومتعاطفة مع المغلوبين، ومنحازة إليهم.
محتوى القراءة
يقدم الباحث في نهاية الفصل الأول من الكتاب مراجعة وصفية لمفاهيم النهضة والتقدم والتنوير والحداثة كما تصورها مفكرون عرب معاصرون، ويضمن هذا القسم مقتطفاتٍ مطولة أحياناً من كتب بعض هؤلاء المفكرين وشروحاً وتعليقات تتصل بمفاهيم العقل والحرية والتقدم والإنسان والاستنارة والعقلانية والفردية والأمة والحداثة… إلخ. ثم ينتقل في الفصل الثاني لاستعراض نماذج من القراءات الجديدة للمنتجات الفكرية لعصر النهضة العربي، ويصنف هذه القراءات في نمطين يتناول كل منهما بعداً محدداً.
البعد المعرفي الثقافي
في هذا المستوى يتعرض الباحث لعدد من المفكرين العرب الدارسين لفكر النهضة من أمثال الكاتب المغربي كمال عبد اللطيف الذي يؤاخذ فكر النهضة بسبب جمعه بين المفاهيم والمنظومات الفكرية الأوروبية والمفاهيم الإسلامية العائدة للعصور الوسطى، دون التمييز بين أسس هذه المفاهيم وأبعادها ونتائج هذه الأسس والأبعاد في الفكر والممارسة، وهو ما يؤدي إلى تعليق الاختلافات وخلط أوراق الأفكار والأزمنة والعصور، فيصالح المتخاصم دون مراعاة حدود النظام والترتيب وقواعد إنتاج المنظومات النظرية. ومثل هذا الموقف يؤدي -حسب الكاتب المذكور- إلى إهمال الانتباه لتاريخية المفاهيم ودلالاتها الفلسفية، وما يختفي وراءها من مقاصد وأهداف وتجارب مجتمعية، لها شروط محددة هي ظروف تكوينها الخاصة في الزمان والمكان، الأمر الذي يكون له صدى واقعي يتمثل في الحاجة الملحة التي يجدها المصلحون إلى “أسلمة” كل القيم والمفاهيم والمؤسسات الأجنبية لكي يتم إعطاؤها شرعية الوجود، ويصبح عندئذ ما وفد من مفاهيم ومؤسسات ليس أجنبياً ولا غريباً، بل يجد سنداً شرعياً وأصولاً له في الإسلام. هذا بالنسبة للجيل الأول من المصلحين والرواد الذين انفتحت عيونهم على الغلبة الغربية فاندمجوا في سياقها بوعي أو بدون وعي.
أما الجيل الثاني من المفكرين العرب وهم ليبراليون في عمومهم، فإن عزلهم الأفكار والمناهج عن إطارها التاريخي والثقافي الذي تشكلت فيه جعلهم بسبب الفاعلية التلقائية لعمل المنهج الليبرالي يغفلون واقعهم الخاص ويطرحون -بتأثير من منطلقاتهم العقدية ومنهج تفكيرهم- قضيتهم على مدى نصف قرن وفقاً لرؤية غربية عن التكوين النفسي والتاريخي لواقع مجتمعاتهم، فسقطوا بذلك في استنساخ تجربة في غير شروط تحققها. لقد رأوا أن الأخذ بشعارات البرلمانية التمثيلية، والتعليم، وتطوير واقع المرأة، والأخذ بالقيم الفكرية والسلوكية التي اتبعها الغرب، والأخذ بمبدأ التصنيع، وحسبوا أن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى تطوير المجتمع وتقدمه مثلما تقدمت وتطورت أوربا، إلا أن ذلك قاد في الأخير إلى جعل النهضة والتحديث والإصلاح شعارات فاقدة لأي مضمون، وذلك أن دعاة المنهج الليبرالي لم يستطيعوا استيعاب الطابع التاريخي الخاص بهذا لمنهج، أي نسبيته وخصوصيته وارتباطه بحقبة تاريخية معينة في مجتمعات محددة، وتورطوا في نقله كما هو إلى واقع تاريخي واجتماعي ومادي مختلف.
أما المفكر المغربي علي أومليل فهو يرى أن لكل عصر نظام ثقافي آخر من دون استيعاب الظرفية التاريخية والشروط المعرفية (الإيبستيمولوجية) التي أنتجت هذه المعارف يفضي إلى انفصام هائل بين الفكر وسياقه الواقعي، إذ ليس لأي مفهوم دلالة مطلقة فوق الثقافات المتغايرة والمتغيرة. ويشير أومليل في هذا الصدد إلى أن علاقة الفكر العربي الحديث بالواقع العربي “تتميز بتباعد هائل لأن هذا الفكر يلهث وراء (أو يهاجر إلى) مثال”. وهذه الهجرة تنطبق في نظر أومليل على الاتجاه الإسلامي والليبرالي اللذين استغرقا في أطر مرجعية إسلامية أو غربية، وتعالياً عن حركة المجتمع و”دينامية” علاقاته وتحولاته. أما طارق البشري في نقده لتجربة النهوض المصرية والتركية وبلوغهما الذروة في تقليد النموذج الغربي، فيرى أن الإصلاح يمكن أن يكون ضالاً لا يفضي في السياق المأخوذ إليه الأثر الذي كان مرجواً، لأن العبرة ليست في نقل المؤسسات أو اقتباسها، وإنما العبرة في فاعلية الإجراء المتخذ بقياس أثره في البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم. ويرى برهان غليون مأزق فكرة النهضة يكمن في الاعتقاد بأن الأخذ بنفس مبادئ الأوربيين يقود إلى التقدم بطبعه، بمعنى أننا بهذا الاعتقاد نكون قد ألغينا التاريخ وألغينا العلاقة التاريخية بيننا وبين الغرب، وألغينا كل صيرورة المسلسل التاريخي الاجتماعي الذي أدى بأوروبا إلى ظهور الثورة الصناعية والثورة السياسية، واستبدال هذا المسار التاريخي المعقد بقرار لا تاريخي هو الأخذ أو عدم الأخذ بمبادئ الأوربيين.
كل ذلك يعني في نهاية التحليل أن الموقف التوفيقي الذي عبر عنه تيار الإصلاح الإسلامي الليبرالي لا يعبر -في رأي مؤلف الكتاب- عن موقف مستقل متماسك فكرياً وثقافياً، لأن الخلط بين المفاهيم يربك الفكر والثقافة، ولا يؤسس لمقالة مستقلة بل يظل عملية انتقائية رجراجة.
البعد السياسي للقراءات حول النهضة
يورد الباحث تحت هذا العنوان نصوصاً لمفكرين عرب ثم يعقب برأيه ونقده لهذه النقول. فالمفكر المغربي محمد عابد الجابري يرى أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد انطلقت بالدعوة إلى الانتظام في تراث والعودة إلى أصول. وهذه العودة إلى الماضي والاعتصام به إنما تتم من أجل تجاوزه هو والحاضر إلى المستقبل. وتتغير آليات النهضة عند وجود خطر خارجي لتصبح آليات دفاعية، وبذلك تتحول العودة إلى الماضي بقصد تجاوزه إلى ركون إليه واستغراق دائم فيه. إلا أن الخطر الخارجي -وهو يدفع إلى الماضي للاحتماء به- هو الذي يفجر السؤال النهضوي بسبب الطبيعة المزدوجة التي يبدو فيها بوصفه -في الوقت نفسه- خطراً زاحفاً ونموذجاً مغرياً للحداثة والتقدم.
وبعد إيراد نصوص أخرى تتعلق بالبعد السياسي في قراءة النهضة، يخلص الباحث إلى أن عملية تحديد “ميكانيزمات” النهضة وآلياتها وتقييمها وتحقيب مراحلها التاريخية ورصد استجابة تياراتها الفاعلة، ليست عملية معبرة عن “وعي الذات”، وإنما هي تكرار لوعي الغالب -أي الغرب- وما يقدمه من “صورة” عن وعينا لذاتنا، الأمر الذي يجعل “مقياس قراءات تاريخ الفكر منذ بداية النهضة واليقظة تكراراً محلياً يستعيد مسلمات يقدمها الغرب”، كما يقول الدكتور سهيل القش، أي أن الغلبة بما لها من تنظير أيديولوجي هي التي تشكل مرجعاً للقراءات وتعوقها عن إمكانية إيجاد معايير خارج القوالب الفكرية والنظرية والأوربية التي تسعى إلى إلغاء تاريخنا واختزاله وجعله تكراراً مملاً لتجارب أوربا في القرون الوسطى وما بعدها.
النهضة والتقدم في التجربة التاريخية العربية المعاصرة
المجتمع والدولة لحظة الاصطدام بالغرب
يمكن النظر إلى تجربة محمد علي باشا السياسية وتجربة رفاعة الطهطاوي الثقافية بوصفهما تجربتين نموذجيتين معبرتين عن تجربة التحديث في الوطن العربي والإسلامي. لقد كانت حركة محمد علي في منطلقها تندرج في سياق حركة الاجتماع السياسي الإسلامي التقليدي وقوانينه الداخلية، أي يمكن إدراجها ضمن صراع العصبيات وتوسعها بالمفهوم الخلدوني، وهي الخاصية التي تميزت بها مسيرة التاريخ العربي الإسلامي. وكان من الممكن أن يتسع نطاق هذه الحركة في المناطق التي خضعت تاريخياً للدولة الإسلامية، أي ما يسميه الفقهاء دار الإسلام. وهذا يعني أن هذه الحركة لم تكن حركة قومية أو إقليمية، فالعوامل التي حجمت المشروع وأعطته طابعاً إقليمياً عربياً، ثم مصرياً، هي عوامل أوروبية خارجية أملتها المصالح والحسابات الاستراتيجية للغرب. وإذا كانت تقويمات معظم المفكرين العرب تجمع على اعتبار هذه التجربة صاحبة الفضل الأول في إدخال النهضة والحداثة بوصفها مشروعاً عملياً متكاملاً، وفي الانطلاق للأخذ بأسباب القوة العصرية، فإن لهذه التجربة وجوهاً أخرى لا بد من إبرازها. فقد اقترن تحديث الدولة منذ البداية بتحطيم الباشا الجديد للقوة التي رفعته إلى سدة الحكم من خلال تشتيته شمل مشايخ الأزهر، ونفي زعيمهم السيد عمر مكرم إلى دمياط، وضرب موقع الأزهر الاجتماعي عن طريق السحب التدريجي للسلطة التعليمية من يد شيوخه، وإنشاء مدارس عسكرية وتقنية حديثة.
وما أن جاء العقد الرابع من القرن التاسع عشر حتى كان نظام موازٍ للتعليم التقني واللغات قد تكون ونما لا يخضع للأزهر وتوجهاته. هكذا ومع مرور الزمن، أصبحت لمحمد علي نخبته المنفصلة عن الجماعة، وانقطعت بصورة شبه نهائية صلة الوصل الشرعية بين المجتمع والدولة، وبات الانفصال بين الصفوة الحاكمة والجماهير التي تشكل مادة مشروع محمد علي النهضوي ووقوده هو الظاهرة الأبرز. وعندئذ تم “عصر” المجتمع المصري لصالح تحديث قسري تركز في السلطة المنفصلة عن الجماعة، وعرفت البلاد التجنيد الإجباري الواسع، وأعمال السخرة، ولم تبق حرفة أو مهنة أو ملكية قارة أو منقولة إلا ووضع الباشا عليها يده. وأصبحت الدولة تتربع في خواء اجتماعي كامل، وتمد أذرعها في كل الاتجاهات لتلتف على جسم المجتمع وتوحده وتعقلنه من الخارج وتدخله في الدائرة الأوروبية من رأسه، أي من الدولة نفسها. وقد كان من شأن هذه التطورات أن جعلت من مشروع محمد علي صورة مأساوية لتركيز القوة وتجميعها في موقع واحد بشكل لا مثيل له في تاريخ الاجتماع السياسي الإسلامي. وقد تم ذلك من خلال دفع الاختلال الحاصل –قديماً- في بنية الدولة الإسلامية إلى أقصاه، مع تعميق القطيعة وإلغاء صلة الوصل الشرعية بين المجتمع والدولة ونخبتها الحديثة، الأمر الذي يصدق في وصفه قول برهان غليون بأن “هذه النهضة لم تكن إلا نهضة البعض واختناق الآخرين”، أي نهضة النخبة والدولة السلطوية المركزية واختناق للجماهير، أو نهضة على هامش المجتمع، وهو ما كان يسهل زعزعتها من الخارج وتشويهها وتحويلها إلى رافد في تيار الهيمنة الغربية الكاسحة.
أما بالنسبة لوظيفة الثقافة وإسهامها في العملية التحديثية، فإن الطهطاوي يمكن أن يمثل علماً من أعلام هذا الوظيفة وهذا الإسهام. فلقد نشأ الرجل وتشكل في سياق تجربة محمد علي ومشروعه التحديثي. وكان الموقع الذي احتله الطهطاوي يتطلب منه توفير المسوغات الفقهية والسياسية لخيارات التجربة التحديثية. وبذلك فإنه لم يكن يصدر عن المنظومة المفهومية الفقهية فحسب، بل عن الفهم الرسمي السلطاني لهذه المنظومة كما يرى ذلك الجابري. وقد أدى ذلك بالطهطاوي إلى أن يرى “أن للملوك في ممالكهم حقوقاً تسمى بالمزايا… فمن مزايا الملك أنه خليفة الله في أرضه، وأن حسابه على ربه، فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من رعاياه”، “ومن مزايا ولاة الأمور أن النفوذ الملكي بيدهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك”، وأنه “كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر الممالك انتخابياً بالسواد الأعظم وإجماع الأمة، ولكن لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب والاختلافات اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح اختيار التوارث في الأبناء وولاية العهد”. وبذلك تكون وظيفة الثقافة والنخب المثقفة، والطهطاوي علم من أعلامها، في عملية التحديث العربية إسناد الدولة الكليانية ودعمها في مشروع إخضاع المجتمع وعقلنته من خارجه، وذلك لأن القاعدة الثقافية ونخبها الحديثة مفصولة عن مجتمعها، ومحكومة في أقدارها ومصائرها بوظائف الدولة، على عكس ما كان عليه الأمر في تجربة التحديث الأوربية التي مثلت مساراً تاريخياً معقداً قاد المجتمعات الأوربية إلى نوع من تدجين السلطة، نهضت فيه النخب المثقفة بمهمة جليلة في الحد من نزوعات الهيمنة السلطوية، وفي جعل الدولة في خدمة مواطنيها. أما تحديث الدولة العربية الإسلامية فقد تم على حساب الوجود السياسي والاجتماعي للكتل الشعبية مما انعكس عليها انحلالاً وتفسخاً وتفككاً وتغريباً وقمعاً.
مقاومة المغلوبين
لقد اقتصر التفكير في مسألة النهضة إلى حد الآن على النخبة الفكرية ومواقفها، ولكن ذلك -على ضرورته وأهميته- يبقى غير كاف لأنه مرتبط بتحليل مركبات ذهنية وإرادات ومثل عليا ونماذج ثقافية أكثر من ارتباطه بتحليل الواقع الموضوعي التاريخي الاجتماعي الذي يمثل موقف الجماهير ورد فعلها التاريخي إزاء المدنية الغربية الغازية. وقد لقي ذلك الواقع إهمالاً وتجاهلاً كبيرين، وخاصة من الفكر العلماني العربي، وهو ما يجعله في حاجة إلى قراءة خاصة تعيد الاعتبار للجماهير ولحركاتها وثوراتها وهمومها.
إن انهيار السلطنات الحاكمة ومختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تحت سنابك الغزاة المستعمرين لم يستتبع انهيار المجتمع، بل على العكس من ذلك أثبتت معطيات الصراع بين النموذج الغربي الحديث والمجتمع الإسلامي أن الدولة لم تكن تشكل المفصل الوحيد المدافع عن المجتمع الإسلامي، بل لم تشكل هذه الدولة المفصل الأساسي في عملية الصراع هذه. فقد تركزت نقاط المقاومة وخطوطها أساساً عبر حركات إسلامية ذات طابع أهلي كان رد فعلها النمطي هو الرفض القاطع والكامل للغرب: رفضه بوصفه احتلالاً وهيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية، ورفضه بوصفه أسلوباً في الحياة والتنظيم. ولكن هذه المقاومة قد اندحرت في الأخير على الرغم من البسالة الأسطورية لبعض قياداتها ورموزها، وهو ما مهد لقبول ردي فعل نمطيين آخرين هما المحاكاة والتوفيقية التصالحية مع الغزاة. وعلى الرغم من إخفاق المقاومة الأهلية، إلا أنها قد نجحت إلى حد كبير في صون شخصية الشعوب الإسلامية من الاندثار وحفظت هويتها من الضياع، وضمنت نوعاً من التواصل التاريخي والثقافي الاجتماعي للشعوب الإسلامية في مواجهة زحف شمولي يريد أن يقطعها عن الأصول والهوية والتاريخ.
أما المقاومة الثانية أو ما اصطلح على تسميته بالحركات الوطنية -وهي الحركات التي نشأت في صفوف الفئات الحديثة- بعد أن قطعت الغلبة الأوربية بعض الشوط في تركيز علاقاتها الرأسمالية والسلطوية والثقافية وفي بناء أجهزة الحكم ومؤسسات الإدارة الحديثة، فإنها نشأت لكي تنازع القوة المسيطرة على “اقتسام الأَوْرَبة” وعلى حصة اقتصادية وسياسية. ولقد أخفق هذا الخيار في تحقيق النهضة الحضارية، ذلك أن الإصلاح في ظل التسليم بالغلبة والتفوق الحضاري للغرب يعني تغيراً وتقدماً وتحديثاً وفقاً لنموذج الغالب والمتفوق في الحضارة والثقافة، مما يؤول إلى مزيد من الاختلال والتفسخ في الهيئة الاجتماعية للشعب المغلوب. إن المسألة المركزية بالنسبة لتيار المقاومة الشاملة الأولى مسألة سياسية، ولم تكن مسألة ثقافية وتربية وتعليم وإصلاح جزئي. أما بالنسبة للمقاومة الثانية أو الحركات الوطنية فقد أدت ظرفية الاختراق والضغط الأوروبي بالمفكرين للتعاطي مع الأفكار الاجتماعية والمبادئ السياسية الغربية لتنظيم المجتمع والتسليم بها واقعاً لا مفر منه. ولكن موقفاً من هذا القبيل كان يعني مزيداً من الإرباك والتفكك والانقسام الداخلي والضعف والتآكل. لقد استطاع المشروع الإمبريالي أن يحتوي الصراع على أرضية علاقاته السياسية والاقتصادية وضمن منظوره ومفاهيمه، فأصبح السؤال الذي تطرحه الحركات الوطنية هو كيف نسرع في بناء الدولة الحديثة، وفقاً للنموذج الغربي؟
انكفاء الدين وغلبة مجتمع النخبة الحديثة: التغريب
لم يكن الاستعمار الغربي ليكتفي بالغلبة الظاهرة، وإنما كان يريد التوغل في عمق الإسلام لضرب القوة الباطنة، هذه القوة الكامنة في الدين برغم الهزيمة السياسية والعسكرية والانهيار الحضاري الشامل. وبما أن وجود الجماعة المسلمة ملتحم بالشرع، فإن نفي هذا الأخير وتطويقه وتهميشه وعزله بات يشكل هماً استراتيجياً عند الغالبين. غير أن واقع الهزيمة الكاسحة واستهداف عقيدة المغلوبين وثقافتهم ولحمة عراهم ورأس أمرها الذي هو الشرع، جعل المجتمع الأهلي لا يتردد في رفضه المطلق للتغريب وللخروج عن الدين، ولم يبق أمامه سوى التمسك بما يؤسس للجماعة كيانها، وبالتالي كان خياره أن يلجأ إلى الماضي بما هو ذكرى أمجاد وقوة يتعصب لها ويحتمي بها.
هذه العودة للماضي لم تر فيها النخب التحديثية إلا مظاهر للتقليد الأعمى، وترديد الظواهر الموروثة، وتكرار الحدث التاريخي في زمن دائري، وجمود الحركة، واختصار الحياة برتابة العبادة. وفي الحقيقة نحن هنا أمام حركة منكفئة تبدو كأنها قاربت الفناء، إلا أن ذلك لا يقود إلى الفناء. وإنه وإن لم تكن هذه المقاومة هي الحل المثالي الأفضل، إلا أنها مثلت مرحلة تاريخية دفاعية سمحت للمجتمع الإسلامي -في حدود معينة- بإعادة إنتاج نمط حياته ونسقها الخاص. غير أن النخب التي تفقهت على أساطين ثقافة الاستعمار في إطار تأهيلها لقيادة المجتمعات المتفسخة لم تر في هذه المقاومة وفي رموزها من النخب التقليدية إلا عائقاً أمام التحديث و”العصرنة”. وبعبارة أخرى رأت فيها حاجزاً أمام المجتمع النخبوي الحديث الناشئ في سبيل الانتقال السريع والنهائي إلى مواقع الثروة والسلطة. غير أنه بفعل هذه النخب المتغربة لم يعد التغريب وقفاً على جهود فردية بل تعدى ذلك إلى أن يصبح ثقافة وإيديولوجية مهمتها تعميم التغريب بتحويله إلى فكر ومؤسسات ودول، وباختصار تحويل الغرب بما هو ثقافة وحضارة ونمط حياة إلى حالة داخلية. وكان ارتداء التغريب “ثياباً إسلامية” يعني أن الستار الحديدي الذي ضُرب حوله قد بدأ يتهاوى، وبات التغريب يتسرب إلى داخل الجسم الإسلامي ليعلن بداية تناقض الجماعة مع ذاتها. وقد تم ذلك بوضوح في الدول الوطنية التي قد يكون الكثير من زعمائها استغل قيم المجتمع التقليدي ومشاعره الإسلامية لغرض تعبئة الجماهير بهدف الحصول على مكاسب سياسية في المدى القصير. وما أن تمكنت هذه القيادات من تحقيق تلك المكاسب كجلاء الاستعمار، حتى أعلنت الحرب على تلك القيم والمشاعر الإسلامية ذاتها. فقاد ذلك إلى مزيد من الانكفاء على الماضي والتعصب للقيم والتقاليد بوصفه السلاح الوحيد الباقي. وبهذا المعنى يظهر التعصب بوصفه علاقة فارقة تكشف الجماعة بواسطتها عن إرادة التمايز عن الغرب الغالب وعن موقفها الرافض للأمر الواقع.
تجربة التقدم الراهنة: فتنة الحداثة
تحررت الدول العربية من الاستعمار وانتقلت السلطة من أيدي المستعمرين إلى أيد وطنية، وكانت وسيلة ارتقاء مدارج السلطة الجديدة هي -إلى حد كبير- العلم والتربية ونظام التعليم الحديث. وإذا كان المطلبان الإصلاحيان الكبيران للمفكرين النهضويين منذ نهاية القرن الماضي هما إصلاح المؤسسة السياسية من جهة وإصلاح التربية والتعليم من جهة ثانية، فإن تحقيق هذين المطلبين كان ركيزة لبناء مجتمع النخبة -نخبة الدولة الحديثة- واستمراريته. ولقد استندت إيديولوجيا النخب الحديثة في النهوض بمجتمعها وإدراجه في سياق التاريخ العالمي إلى مفهوم مركزي هو مفهوم البناء القومي، وهو مفهوم يعد الدولة في العالم الثالث ضرورة لقيادة المجتمع نحو التلاحم الداخلي والتقدم الحضاري، وهو ما يشكل حجر الزاوية في إيديولوجيا “تقدمية” تمثل مصدراً لشرعية الدولة الحديثة. إلا أنه بعد أربع عقود من وهم البناء القومي وبناء الدولة الحديثة لم يتحقق الهدف المنشود بل تحقق عكسه. فالسيادة الوطنية تحولت إلى تبعية شاملة، والشرعية الداخلية تحولت إلى حكم القوة، والتنمية والتلاحم الداخلي إلى تنمية للتخلف، وتفكك اجتماعي وقومي متزايدين. فأصبحت دولة البناء القومي دولة للخراب القومي، وتحولت دولة المجتمع والأمة إلى دولة عداء للمجتمع وقهر للأمة، وأضحت الدولة الوطنية مجرد وكالة لقوى أجنبية. ولم تشهد المجتمعات العربية الإسلامية في ظل دولة التحديث لا إدارة عقلانية للموارد وتوزيع الثروة، ولا اندماجاً للمجتمع في السياسة أو للسياسة في المجتمع. وظهرت الدولة الحديثة -وخاصة أثناء الأزمات- على حقيقتها قوة أكثر همجية وأكثر انحطاطاً من نموذج الدولة السلطانية القديمة.
أما على الصعيد الثقافي وصعيد الوعي، فإنه عندما لم تنهض الذات التراثية من كبوتها ولم تحقق التقدم والتحضر وبقي العالم العربي على حاله، لم تجد النخب الحديثة من تفسير لهذا القصور إلا في التراث الذي نظر إليه على أنه قيد يحرم الوعي من الانطلاق نحو العصر وقيمة ومنتجاته. ولكن في الحقيقة فإن مشروع الدولة الحديثة والتقدم العصري، وهو المشروع الذي قاد المجتمع والدولة العربيين خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعني أن نقد الفكر التقليدي أو السلفي عمل تضليلي، لأن الفكر التقليدي فكر مغلوب لم يكن في موقع سلطة القرار طوال المرحلة الماضية، وبالتالي فهو غير مسؤول عن الكوارث التي آل إليها المشروع التحديثي العربي.
لقد انتهى على الصعيد الثقافي صراع الأصالة والمعاصرة مع نشأة دولة الاستقلال بنصر كاسح للتيار العصري، تيار الحداثة. وظهر صراع جديد بين يمين الحداثة ويسارها وعلى ساحتها الداخلية، أي أصبح صراع النخب العربية -بعد أن كان صراعاً بين القديم والحديث أو بين الفكر الديني والفكر العقلاني- صراعاً بين مدرستين في فهم القرب ذاته: المدرسة التقدمية الاشتراكية والمدرسة المحافظية البرجوازية. وغُيب الفكر التقليدي عن ساعة الصراع وإدارة الشؤون العامة لصالح فكر الحداثة بشقيه، فكيف يحمل هذه الفكر المغيّب نتائج تجربة لم يشارك في صياغتها؟ وفي هذه الحالة يكون السؤال الحقيقي إنما هو السؤال الذي يطرح للبحث والنقد حصيلة قرن أو أكثر من تجربة الحداثة العربية التي انتهت إلى ما يسمى “عصر الأزمة المفتوحة” أو “الانهيار الشامل” أو “الانحطاط المعاصر” أو إلى ما سماه المفكر الجزائري مالك بن نبي بالتكديس بدل البناء. فهل شهد الوضع العربي مع الأنظمة والنخب التحديثية الموجهة لدفة السياسة والثقافة والاقتصاد نهضة وحداثة؟ وهل قامت النهضة أم لم تقم؟ ولماذا لا يُسأل عن هذا الانحطاط والتخلف العربيين الراهنين دعاة الحداثة والمبشرون بها؟ أليس لاستمرار ذلك وتفاقمه علاقةٌ مباشرة بوجود تجربة الحداثة والنهضة المعاصرة وما نتج عنها من تحطيم للتكوينات الاجتماعية السياسية الثقافية التقليدية، ومن تركيز للسلطة واختلال للتوازن لصالح أجهزة الدولة التي انفصلت كلياً عن المجتمع، ومن تزايد القدرة على القمع من خلال تحديث أجهزة القهر وآلاته المستوردة؟
وأخيراً فإن الحداثة -كما طبقت في المجتمعات العربية الإسلامية- قد أضرت بإمكانية النهضة والتقدم الحقيقيين والنافعين. وقد أثبتت الوقائع التاريخية أن الأرضية الغربية التي سادت في بلداننا باسم شعار الحداثة لم تأت لتحقيق تقدماً وتطوراً، بل دمرت عوامل التقدم والرقي حين حطمت مصادر الاستقلالية في النسق الاجتماعي الحضاري العربي الإسلامي، ذلك أن المحاولات النهضوية الإصلاحية لم تكن بمادة الكيان الحضاري التاريخي تطويراً وتعديلاًن بل كانت انخلاعاً أو عدولاً عنه إلى وافد خارجي غريب، وهو ما يعني أن الخلل في مشروع النهضة بدأ مبكراً منذ تجربة محمد علي والطهطاوي، مروراً بطروحات محمد عبده ورشيد رضا، وانتهاءً بمدارس التحديث في دول الاستقلال حيث تحولت جرعة التغريب والتفرنج أو “الأوربة” إلى عنصر رئيسي بل العنصر الوحيد في مشروع اختيارنا النهضوي، في حين كان الهدف منها التنوير والإحياء والمراجعة وليس أكثر من ذلك.
لقد أنتجت الحداثة مجتمعاً عاجزاً مفتوناً منقسماً على نفسه بين جموع شعبية مجهَّلة مفقَّرة، مقصاة من كل الثمرات الإيجابية للحداثة، حاملة وزر هذا التحديث المغشوش، ومجتمع نخبة “أقلوي” (نسبة إلى الأقلية) منفصل عن المجتمع التقليدي وقيمه وثقافته، مجتمع يعيش فكرياً وعاطفياً في دول الغرب وعواصمه ويقدر على التفاهم مع المجتمعات الغربية أكثر من قدرته على التفاهم مع مجتمعه الأم.
وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال الفكر العربي لم يدرك بعدُ أن الحداثة يمكن أن تكون عنصر تفكيك وتدمير. ومع ذلك ليس المطلوب إلغاء الحداثة، بل المطلوب السيطرة عليها. إن المطلوب هو الوعي بأن الحداثة من موقع الغلبة السياسية والحضارية الشاملة لا يمكن أن تنشر وتعمم إلا الفتنة والتفسخ والتفكيك، وأن المسألة الأساسية هي: كيف يسيطر المجتمع الأهلي أو الأمة على الأدوات التحديثية كي لا تتحول إلى أدوات تدمير، بدل أن تكون أدوات إعادة بناء المجتمع والأمة.
وفي النهاية يخلص الباحث إلى أنه قد فات أوان الاختيار الموضوعي بين الأصالة والحداثة، أو بين الموروث والوافد، ذلك أن هذا الصراع قد وقع تجاوزه ولم يعد قادراً على إنتاج الأسئلة والإجابات الموجهة لإمكانات النهوض. فمضمون النهضة الحضارية المأمول أن تسير نحوها الأمة تواصلاً مع منطق الاستمرارية التاريخية هو تحرير الإنسان من عبودية الأصنام السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية كافة، ومن دون ذلك لا يمكن للتقدم والحداثة أن يكونا صالحين ونافعين.
خلاصات وملاحظات:
تتميز هذه الدراسة بطرح الأسئلة أكثر من اهتمامها بالأجوبة الجاهزة. وقد نجح الباحث في إثارة العديد من الأسئلة وفي تصويب أسئلة أخرى مطروحة من قبل وفي تدقيقها وتعديلها. فعدل سؤال الأمير شكيب أرسلان: “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” إلى سؤال جديد يكمل هذا السؤال ويدققه هو: لماذا لم نتقدم نحن بعد زهاء قرن من محاولات النهوض والتقدم؟ وبذلك يكون الباحث قد وجه إصبع الاتهام إلى النخب والدول التي تبوأت قيادة مشروع النهضة والحداثة وانتهت به إلى الفشل الذريع والأزمة المفتوحة والانكشاف الشامل. ثم يتساءل الكاتب عن طبيعة النهضة والحداثة التي جربناها وهل كما شهدنا نهضة وحداثة؟ أم كانت جهود النهضة والتحديث مجرد تكديس بدل أن تكون بناء، ويتساءل كذلك عن كيفية سيطرة المجتمع الأهلي على الأدوات التحديثية كي لا تتحول إلى أدوات تدميرية.
لقد نافح الباحث عن الثقافة التقليدية -ثقافة المجتمع الأهلي والأمة أو ثقافة المغلوبين- وأنصفها في ظل هجوم مركز ضدها، وأدان المنهج التوفيقي الذي انتهى إلى أن يكون جسراً يعبر من خلاله التغريب إلى عقر الإسلام ووطنه، وبين عجز مفكري هذا المنهج عن استعاب تاريخية المفاهيم وارتباطها ببيئتها الاجتماعية والحضارية والشروط التاريخية لتكوينها وتبلورها، وانتهى إلى أن مفهوم الحداثة -كما شاع استخدامه والدعوة إليه في الأدبيات العربية- ليس له من محتوى حقيقي من الناحية المعرفية والعلمية، وأنه لا يقدم أجوبة وحلولاً تلقائية لمشاكل الأمة، متهماً مجتمع النخبة الحديث ودول الحداثة والاستقلال الوطني، وكاشفاً ما وصلت إليه تجاربها من كوارث على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وإذا كان الباحث قد أصاب في مجمل ذلك، إلا أنه في نقده للتيار التوفيقي وأثناء تأكيده تاريخية المفاهيم ونسبيتها وارتباطها بظروف نشأتها، يبدو كأنما جعل من الثقافات والحضارات قارات معزولة تفصل بينها حواجز وموانع تعيق تواصلها وأخذ بعضها عن بعض وانتقال القيم والأفكار فيما بينها، أي أنه كأنما ألغى التواصل و”التثاقف” بين الحضارات والمجتمعات، أو على الأقل قلص هوامشه إلى أبعد الحدود. وإنه إذا صح تاريخياً في تجربة النهضة العربية الحديثة أن منهج التوفيق والاقتباس قد انتهى إلى تقويض الثقافة الأصل وأدمج المجتمع العربي الإسلامي في تيار التغريب و”الأوربة” بشكل مشوه، فليس الخلل في التوفيق والاقتباس في حد ذاتهما وإنما في الشروط التاريخية والمادية والاجتماعية التي رافقتهما أثناء هذه التجربة. وإذا كان المؤلف يشير إلى ذلك في أكثر من مكان، فإن حملته العنيفة على التجربة التاريخية في التوفيق والاقتباس -وهي تجربة مخفقة- قد تثير بعض الغموض حول المبدأ من أصله، وهو مبدأ لا يجب الحكم عليه من خلال تجربة مخفقة، فقد كان ولا يزال الأخذ والاقتباس بين الحضارات وسيلة للتواصل والتوارث والإضافة والتجديد.
لقد انتقد الباحث تجربة التحديث العربية بعنف وكشف مآلاتها ومآزقها مسمياً الأشياء بأسمائها، وانتهى إلى اقتراح وجهة لمحاولات النهوض العربية تتمثل في خوض معركة النهضة على أرضية النضال من أجل الحرية وتحرير الإنسان من الأصنام الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية. ولكنه انتهى -كما رأينا من قبل- إلى أننا اليوم بفعل تراكمات محاولات التحديث قد فاتنا أوان الاختيار الموضوعي بين الأصالة والحداثة أو بين الموروث والوافد. فعلى أي أرض نقف إذن لخوض مشروع معكرة النهضة والتحرر؟ وهل بلغ بنا الأمر إلى حد التشكك في الأرض التي سنقف عليها لمحاولة الانطلاق من جديد؟ وهل انتهى حقاً زمان اختيار الأرض التي يسعنا الانطلاق منها؟ ثم هل بإمكاننا أن نختار -من أجل بناء ونهضة حقيقيين- أرضاً غير أرض الأصالة، قاعدة للانطلاق، منفتحة على إنجازات البشرية المختلفة لاستيعابها ودمجها في تربتنا الحضارية والثقافية؟
إن عمل فادي إسماعيل على أهميته الكبيرة وعلى الرغم من الجهد الذي قام به للدفاع والمنافحة عن الثقافة التقليدية والقيم الموروثة والجماعة المغلوبة ومقاومتها البطولية التي حفظت تواصل الأمة مع تاريخها وتراثها، إن ذلك كله على جلالة قدره وأهمية نتائجه قد أهدره الباحث من خلال النتيجة التي ختم بها بحثه، وهي الانبتات عن الأرض التي من المفترض أن يقف فوقها وينطلق من قاعدتها في مشروعه للتحرر مقدمة للنهضة والتحديث النافع، عندما تصور أن هذه الأرض قد فاتنا زمان الوقوف عليها بعد أن تراكم فوقها جليد قرن من التشويه والتحديث المغشوش.
إن الحرية اليوم في رأينا ليست إلا ساحة للمعركة من أجل استيعاب الحداثة وهضمها والسيطرة عليها والإضافة إليها، ولكن على أرض الأصالة والموروث الذي يظل في حاجة إلى إحياء وغربلة وتفعيل لمجمل قيمه وبقايا مؤسساته حتى يكون ذلك مدخلنا إلى تقويم الحداثة والإضافة إليها. وإذا كان اليوم من الصعب التخلص من ركام قرن ونيف من ثمار الجهود المركزة للدول والنخب في تحقيق أكبر قدر من التحديث الذي آل إلى المسخ والتشوه، فإن ذلك لا يجعلنا نتوقع إمكانية للنهوض الحقيقي على أرض ثالثة لا هي أرض التحديث ولا هي أرض الأصالة. وستظل أرض الأصالة والموروث هي وحدها الأرض المناسبة للنهوض إذا ما وقع تفعيل هذا الموروث وتجديد طاقته الحيوية.
وأخيراً فإن أي نقد يوجه لهذا العمل لا يمكن أن يقلل من أهميته بوصفه عملاً نقدياً جدياً يقدم كشف حساب صارم للتجربة العربية في التحديث والنهضة والنخب العربية التي وجهت سهام النقد والتفكيك للتراث وللثقافة التقليدية وللقيم الموروثة دون أن تطرح السؤال على سلامة مشروعها وجهودها التحديثية التي انتهت بالوضع العربي إلى تنمية التأخر والتخلف بدل تحقيق التقدم والتحديث.
في تمهيد الكتاب ومقدمته، يحدد الباحث مهمة دراسته على أساس أنها دعوة لعملية قطع تدريجي مع التكوين النظري والمنهجي الذي يتحكم في حركتنا الفكرية والذي هو من مكونات الغلبة الحضارية وسيادة الأنموذج الغربي للمعرفة. ويقرر الباحث أن الأنموذج المعرفي التوحيدي هو الأنموذج القادر -تدريجياً- على القطع مع الأنموذج المعرفي السائد، لأنه الوحيد الذي يفتح آفاق التغيير الكامل، والذي لا يواجه الأنموذج الغربي في جانب لكي يصالحه في جانب آخر. ثم يضيف أنه ليس من هدف دراسته أن تتعالى على واقع التخلف الذي يرزح تحته العالم العربي والإسلامي، وإنما هي مساهمة في وعي التخلف وجهد ناصب نحو العدل الفكري ووضع الأمور في نصابها حتى لا يحمل الفكر التقليدي والقيم السائدة في مجتمعاتنا مسؤولية التخلف والهزائم. ذلك أن الكثير من الجرائم -كما يقرر الباحث- ارتكب في الفكر والواقع من قبل مجتمع النخبة في أقطارنا العربية والإسلامية باسم الحداثة والتقدم والتنمية: تقدم التبعية وتحديث القمع والاستبداد والتسلط وتنمية المسخ والمجتمعات “المفتونة”، وإنه في النهاية قد مررت تحت عباءة التقدم والحداثة والتنمية إجراءات وأفعال هي في النتيجة ضد الحداثة والتنمية والتقدم.
وعن سؤال الأمير شكيب أرسلان: “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” يرى الباحث أن دراسته محاولة متأخرة للإجابة عن هذا السؤال أو بالأحرى عن سؤال مكمل هو: لماذا بعد أكثر من100 سنة من محاولات النهضة والتقدم والتوفيق مع العصر لم نتصالح معه ولم نتقدم؟ إن السؤال القديم: “لماذا تقدم الآخرون وتأخرنا نحن؟ لم يعد يتحكم بالإشكالية الثقافية الراهنة، بل حل محله سؤال آخر: لماذا لم نتقدم نحن بعد؟ الأمر الذي يجعل من الدراسة محاولة نقدية للخطاب العربي حول الحداثة، وللحداثة بما هي تجربة تاريخية عربية انتهت إلى أن تكون مجرد تطبيق قسري، وتقليد مبتسر، واستهلاك أيديولوجي “للحداثة والتقدم” الغربيين، دون أن يرافق ذلك تحديث للفكر والحريات وللعلاقات والنظم السائدة.
منهجية القراءة
لا يعود الباحث إلى النصوص النهضوية الأصلية، وإنما يحصر قراءته النقدية في الخطاب العربي المعاصر في نماذج مختارة من قراءات المفكرين العرب لمفاهيم وتجارب النهضة والتقدم والحداثة، وتركيب هذه القراءات من خلال ما يبشر به هذا الخطاب من أنموذج مجتمعي ثقافي ينتظم سائر تفرعاته. وليست النماذج الحضارية هنا عند الباحث سوى نموذجين اثنين: النموذج الغربي الأوروبي والنموذج العربي الإسلامي، النموذج الوافد غزواً والنموذج الموروث أصلاً. أما ما اصطلح على تسميته بالأنموذج التوفيقي للتقدم والنهضة فما هو -في رأي الباحث- إلا نظريات لا تقدم سوى حركة ذهنية لدى المثقفين، ليس لها أية تجسيدات حقيقية في أرض الواقع.
وقد أجبر الأنموذج العربي الإسلامي للتقدم على التقهقر والانزواء تاريخياً، وفقد وظيفته التربوية والسياسية والاقتصادية، وانطوى على نفسه متراجعاً إلى خط دفاعي من موقع ثقافة المغلوبين وأيديولوجيتهم. أما الموقف التوفيقي فكان موقفاً مرحلياً انتقائياً وانتقالياً على طريق التغريب والتبعية الشاملة، وبذلك تنتفي أصالته نموذجاً مستقلاً للتقدم والنهضة، بل ما هو في النهاية إلا مساومة على الأصل وتكيف مع النموذج الوافد وتصالح معه. ومن ثم لم يكن الموقف التلفيقي في حقيقته إلا خطوة تاريخية متراجعة لصالح الأنموذج الحضاري الآخر، بوعي من أصحابه أو من دون وعي. بهذا كان التوفيق حركة ذهنية شكلية وقالباً فارغاً يملؤه القادرون على التحكم بحركة الواقع. أما الأنموذج الغربي للتقدم والنهضة فقد أمسى هو المتحكم بالواقع عبر الحضور الأوروبي المباشر في مرحلة الاستعمار، ثم عبر النخب الوطنية القائدة والأيديولوجيا التحديثية في مرحلة ما بعد الاستعمار المباشر، أو ما اصطلح عليه بالاستقلال.
وبناء على هذا التحديد للنماذج الحضارية للتقدم والنهضة، يحدد الكاتب منهجية بحثه في القيام بالأمرين الآتيين:
– قراءة نقدية تفكيكية لثقافة النخبة وأيديولوجيتها والأطروحات النظرية التي تساندها.
– قراءة للثقافة المغلوبة على أمرها ولواقع جماعة المغلوبين، وهي قراءة يريدها الباحث ملتزمة ومتعاطفة مع المغلوبين، ومنحازة إليهم.
محتوى القراءة
يقدم الباحث في نهاية الفصل الأول من الكتاب مراجعة وصفية لمفاهيم النهضة والتقدم والتنوير والحداثة كما تصورها مفكرون عرب معاصرون، ويضمن هذا القسم مقتطفاتٍ مطولة أحياناً من كتب بعض هؤلاء المفكرين وشروحاً وتعليقات تتصل بمفاهيم العقل والحرية والتقدم والإنسان والاستنارة والعقلانية والفردية والأمة والحداثة… إلخ. ثم ينتقل في الفصل الثاني لاستعراض نماذج من القراءات الجديدة للمنتجات الفكرية لعصر النهضة العربي، ويصنف هذه القراءات في نمطين يتناول كل منهما بعداً محدداً.
البعد المعرفي الثقافي
في هذا المستوى يتعرض الباحث لعدد من المفكرين العرب الدارسين لفكر النهضة من أمثال الكاتب المغربي كمال عبد اللطيف الذي يؤاخذ فكر النهضة بسبب جمعه بين المفاهيم والمنظومات الفكرية الأوروبية والمفاهيم الإسلامية العائدة للعصور الوسطى، دون التمييز بين أسس هذه المفاهيم وأبعادها ونتائج هذه الأسس والأبعاد في الفكر والممارسة، وهو ما يؤدي إلى تعليق الاختلافات وخلط أوراق الأفكار والأزمنة والعصور، فيصالح المتخاصم دون مراعاة حدود النظام والترتيب وقواعد إنتاج المنظومات النظرية. ومثل هذا الموقف يؤدي -حسب الكاتب المذكور- إلى إهمال الانتباه لتاريخية المفاهيم ودلالاتها الفلسفية، وما يختفي وراءها من مقاصد وأهداف وتجارب مجتمعية، لها شروط محددة هي ظروف تكوينها الخاصة في الزمان والمكان، الأمر الذي يكون له صدى واقعي يتمثل في الحاجة الملحة التي يجدها المصلحون إلى “أسلمة” كل القيم والمفاهيم والمؤسسات الأجنبية لكي يتم إعطاؤها شرعية الوجود، ويصبح عندئذ ما وفد من مفاهيم ومؤسسات ليس أجنبياً ولا غريباً، بل يجد سنداً شرعياً وأصولاً له في الإسلام. هذا بالنسبة للجيل الأول من المصلحين والرواد الذين انفتحت عيونهم على الغلبة الغربية فاندمجوا في سياقها بوعي أو بدون وعي.
أما الجيل الثاني من المفكرين العرب وهم ليبراليون في عمومهم، فإن عزلهم الأفكار والمناهج عن إطارها التاريخي والثقافي الذي تشكلت فيه جعلهم بسبب الفاعلية التلقائية لعمل المنهج الليبرالي يغفلون واقعهم الخاص ويطرحون -بتأثير من منطلقاتهم العقدية ومنهج تفكيرهم- قضيتهم على مدى نصف قرن وفقاً لرؤية غربية عن التكوين النفسي والتاريخي لواقع مجتمعاتهم، فسقطوا بذلك في استنساخ تجربة في غير شروط تحققها. لقد رأوا أن الأخذ بشعارات البرلمانية التمثيلية، والتعليم، وتطوير واقع المرأة، والأخذ بالقيم الفكرية والسلوكية التي اتبعها الغرب، والأخذ بمبدأ التصنيع، وحسبوا أن ذلك سيؤدي تلقائياً إلى تطوير المجتمع وتقدمه مثلما تقدمت وتطورت أوربا، إلا أن ذلك قاد في الأخير إلى جعل النهضة والتحديث والإصلاح شعارات فاقدة لأي مضمون، وذلك أن دعاة المنهج الليبرالي لم يستطيعوا استيعاب الطابع التاريخي الخاص بهذا لمنهج، أي نسبيته وخصوصيته وارتباطه بحقبة تاريخية معينة في مجتمعات محددة، وتورطوا في نقله كما هو إلى واقع تاريخي واجتماعي ومادي مختلف.
أما المفكر المغربي علي أومليل فهو يرى أن لكل عصر نظام ثقافي آخر من دون استيعاب الظرفية التاريخية والشروط المعرفية (الإيبستيمولوجية) التي أنتجت هذه المعارف يفضي إلى انفصام هائل بين الفكر وسياقه الواقعي، إذ ليس لأي مفهوم دلالة مطلقة فوق الثقافات المتغايرة والمتغيرة. ويشير أومليل في هذا الصدد إلى أن علاقة الفكر العربي الحديث بالواقع العربي “تتميز بتباعد هائل لأن هذا الفكر يلهث وراء (أو يهاجر إلى) مثال”. وهذه الهجرة تنطبق في نظر أومليل على الاتجاه الإسلامي والليبرالي اللذين استغرقا في أطر مرجعية إسلامية أو غربية، وتعالياً عن حركة المجتمع و”دينامية” علاقاته وتحولاته. أما طارق البشري في نقده لتجربة النهوض المصرية والتركية وبلوغهما الذروة في تقليد النموذج الغربي، فيرى أن الإصلاح يمكن أن يكون ضالاً لا يفضي في السياق المأخوذ إليه الأثر الذي كان مرجواً، لأن العبرة ليست في نقل المؤسسات أو اقتباسها، وإنما العبرة في فاعلية الإجراء المتخذ بقياس أثره في البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم. ويرى برهان غليون مأزق فكرة النهضة يكمن في الاعتقاد بأن الأخذ بنفس مبادئ الأوربيين يقود إلى التقدم بطبعه، بمعنى أننا بهذا الاعتقاد نكون قد ألغينا التاريخ وألغينا العلاقة التاريخية بيننا وبين الغرب، وألغينا كل صيرورة المسلسل التاريخي الاجتماعي الذي أدى بأوروبا إلى ظهور الثورة الصناعية والثورة السياسية، واستبدال هذا المسار التاريخي المعقد بقرار لا تاريخي هو الأخذ أو عدم الأخذ بمبادئ الأوربيين.
كل ذلك يعني في نهاية التحليل أن الموقف التوفيقي الذي عبر عنه تيار الإصلاح الإسلامي الليبرالي لا يعبر -في رأي مؤلف الكتاب- عن موقف مستقل متماسك فكرياً وثقافياً، لأن الخلط بين المفاهيم يربك الفكر والثقافة، ولا يؤسس لمقالة مستقلة بل يظل عملية انتقائية رجراجة.
البعد السياسي للقراءات حول النهضة
يورد الباحث تحت هذا العنوان نصوصاً لمفكرين عرب ثم يعقب برأيه ونقده لهذه النقول. فالمفكر المغربي محمد عابد الجابري يرى أن جميع النهضات التي نعرف تفاصيل عنها قد انطلقت بالدعوة إلى الانتظام في تراث والعودة إلى أصول. وهذه العودة إلى الماضي والاعتصام به إنما تتم من أجل تجاوزه هو والحاضر إلى المستقبل. وتتغير آليات النهضة عند وجود خطر خارجي لتصبح آليات دفاعية، وبذلك تتحول العودة إلى الماضي بقصد تجاوزه إلى ركون إليه واستغراق دائم فيه. إلا أن الخطر الخارجي -وهو يدفع إلى الماضي للاحتماء به- هو الذي يفجر السؤال النهضوي بسبب الطبيعة المزدوجة التي يبدو فيها بوصفه -في الوقت نفسه- خطراً زاحفاً ونموذجاً مغرياً للحداثة والتقدم.
وبعد إيراد نصوص أخرى تتعلق بالبعد السياسي في قراءة النهضة، يخلص الباحث إلى أن عملية تحديد “ميكانيزمات” النهضة وآلياتها وتقييمها وتحقيب مراحلها التاريخية ورصد استجابة تياراتها الفاعلة، ليست عملية معبرة عن “وعي الذات”، وإنما هي تكرار لوعي الغالب -أي الغرب- وما يقدمه من “صورة” عن وعينا لذاتنا، الأمر الذي يجعل “مقياس قراءات تاريخ الفكر منذ بداية النهضة واليقظة تكراراً محلياً يستعيد مسلمات يقدمها الغرب”، كما يقول الدكتور سهيل القش، أي أن الغلبة بما لها من تنظير أيديولوجي هي التي تشكل مرجعاً للقراءات وتعوقها عن إمكانية إيجاد معايير خارج القوالب الفكرية والنظرية والأوربية التي تسعى إلى إلغاء تاريخنا واختزاله وجعله تكراراً مملاً لتجارب أوربا في القرون الوسطى وما بعدها.
النهضة والتقدم في التجربة التاريخية العربية المعاصرة
المجتمع والدولة لحظة الاصطدام بالغرب
يمكن النظر إلى تجربة محمد علي باشا السياسية وتجربة رفاعة الطهطاوي الثقافية بوصفهما تجربتين نموذجيتين معبرتين عن تجربة التحديث في الوطن العربي والإسلامي. لقد كانت حركة محمد علي في منطلقها تندرج في سياق حركة الاجتماع السياسي الإسلامي التقليدي وقوانينه الداخلية، أي يمكن إدراجها ضمن صراع العصبيات وتوسعها بالمفهوم الخلدوني، وهي الخاصية التي تميزت بها مسيرة التاريخ العربي الإسلامي. وكان من الممكن أن يتسع نطاق هذه الحركة في المناطق التي خضعت تاريخياً للدولة الإسلامية، أي ما يسميه الفقهاء دار الإسلام. وهذا يعني أن هذه الحركة لم تكن حركة قومية أو إقليمية، فالعوامل التي حجمت المشروع وأعطته طابعاً إقليمياً عربياً، ثم مصرياً، هي عوامل أوروبية خارجية أملتها المصالح والحسابات الاستراتيجية للغرب. وإذا كانت تقويمات معظم المفكرين العرب تجمع على اعتبار هذه التجربة صاحبة الفضل الأول في إدخال النهضة والحداثة بوصفها مشروعاً عملياً متكاملاً، وفي الانطلاق للأخذ بأسباب القوة العصرية، فإن لهذه التجربة وجوهاً أخرى لا بد من إبرازها. فقد اقترن تحديث الدولة منذ البداية بتحطيم الباشا الجديد للقوة التي رفعته إلى سدة الحكم من خلال تشتيته شمل مشايخ الأزهر، ونفي زعيمهم السيد عمر مكرم إلى دمياط، وضرب موقع الأزهر الاجتماعي عن طريق السحب التدريجي للسلطة التعليمية من يد شيوخه، وإنشاء مدارس عسكرية وتقنية حديثة.
وما أن جاء العقد الرابع من القرن التاسع عشر حتى كان نظام موازٍ للتعليم التقني واللغات قد تكون ونما لا يخضع للأزهر وتوجهاته. هكذا ومع مرور الزمن، أصبحت لمحمد علي نخبته المنفصلة عن الجماعة، وانقطعت بصورة شبه نهائية صلة الوصل الشرعية بين المجتمع والدولة، وبات الانفصال بين الصفوة الحاكمة والجماهير التي تشكل مادة مشروع محمد علي النهضوي ووقوده هو الظاهرة الأبرز. وعندئذ تم “عصر” المجتمع المصري لصالح تحديث قسري تركز في السلطة المنفصلة عن الجماعة، وعرفت البلاد التجنيد الإجباري الواسع، وأعمال السخرة، ولم تبق حرفة أو مهنة أو ملكية قارة أو منقولة إلا ووضع الباشا عليها يده. وأصبحت الدولة تتربع في خواء اجتماعي كامل، وتمد أذرعها في كل الاتجاهات لتلتف على جسم المجتمع وتوحده وتعقلنه من الخارج وتدخله في الدائرة الأوروبية من رأسه، أي من الدولة نفسها. وقد كان من شأن هذه التطورات أن جعلت من مشروع محمد علي صورة مأساوية لتركيز القوة وتجميعها في موقع واحد بشكل لا مثيل له في تاريخ الاجتماع السياسي الإسلامي. وقد تم ذلك من خلال دفع الاختلال الحاصل –قديماً- في بنية الدولة الإسلامية إلى أقصاه، مع تعميق القطيعة وإلغاء صلة الوصل الشرعية بين المجتمع والدولة ونخبتها الحديثة، الأمر الذي يصدق في وصفه قول برهان غليون بأن “هذه النهضة لم تكن إلا نهضة البعض واختناق الآخرين”، أي نهضة النخبة والدولة السلطوية المركزية واختناق للجماهير، أو نهضة على هامش المجتمع، وهو ما كان يسهل زعزعتها من الخارج وتشويهها وتحويلها إلى رافد في تيار الهيمنة الغربية الكاسحة.
أما بالنسبة لوظيفة الثقافة وإسهامها في العملية التحديثية، فإن الطهطاوي يمكن أن يمثل علماً من أعلام هذا الوظيفة وهذا الإسهام. فلقد نشأ الرجل وتشكل في سياق تجربة محمد علي ومشروعه التحديثي. وكان الموقع الذي احتله الطهطاوي يتطلب منه توفير المسوغات الفقهية والسياسية لخيارات التجربة التحديثية. وبذلك فإنه لم يكن يصدر عن المنظومة المفهومية الفقهية فحسب، بل عن الفهم الرسمي السلطاني لهذه المنظومة كما يرى ذلك الجابري. وقد أدى ذلك بالطهطاوي إلى أن يرى “أن للملوك في ممالكهم حقوقاً تسمى بالمزايا… فمن مزايا الملك أنه خليفة الله في أرضه، وأن حسابه على ربه، فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من رعاياه”، “ومن مزايا ولاة الأمور أن النفوذ الملكي بيدهم خاصة لا يشاركهم فيه مشارك”، وأنه “كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر الممالك انتخابياً بالسواد الأعظم وإجماع الأمة، ولكن لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب والاختلافات اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح اختيار التوارث في الأبناء وولاية العهد”. وبذلك تكون وظيفة الثقافة والنخب المثقفة، والطهطاوي علم من أعلامها، في عملية التحديث العربية إسناد الدولة الكليانية ودعمها في مشروع إخضاع المجتمع وعقلنته من خارجه، وذلك لأن القاعدة الثقافية ونخبها الحديثة مفصولة عن مجتمعها، ومحكومة في أقدارها ومصائرها بوظائف الدولة، على عكس ما كان عليه الأمر في تجربة التحديث الأوربية التي مثلت مساراً تاريخياً معقداً قاد المجتمعات الأوربية إلى نوع من تدجين السلطة، نهضت فيه النخب المثقفة بمهمة جليلة في الحد من نزوعات الهيمنة السلطوية، وفي جعل الدولة في خدمة مواطنيها. أما تحديث الدولة العربية الإسلامية فقد تم على حساب الوجود السياسي والاجتماعي للكتل الشعبية مما انعكس عليها انحلالاً وتفسخاً وتفككاً وتغريباً وقمعاً.
مقاومة المغلوبين
لقد اقتصر التفكير في مسألة النهضة إلى حد الآن على النخبة الفكرية ومواقفها، ولكن ذلك -على ضرورته وأهميته- يبقى غير كاف لأنه مرتبط بتحليل مركبات ذهنية وإرادات ومثل عليا ونماذج ثقافية أكثر من ارتباطه بتحليل الواقع الموضوعي التاريخي الاجتماعي الذي يمثل موقف الجماهير ورد فعلها التاريخي إزاء المدنية الغربية الغازية. وقد لقي ذلك الواقع إهمالاً وتجاهلاً كبيرين، وخاصة من الفكر العلماني العربي، وهو ما يجعله في حاجة إلى قراءة خاصة تعيد الاعتبار للجماهير ولحركاتها وثوراتها وهمومها.
إن انهيار السلطنات الحاكمة ومختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تحت سنابك الغزاة المستعمرين لم يستتبع انهيار المجتمع، بل على العكس من ذلك أثبتت معطيات الصراع بين النموذج الغربي الحديث والمجتمع الإسلامي أن الدولة لم تكن تشكل المفصل الوحيد المدافع عن المجتمع الإسلامي، بل لم تشكل هذه الدولة المفصل الأساسي في عملية الصراع هذه. فقد تركزت نقاط المقاومة وخطوطها أساساً عبر حركات إسلامية ذات طابع أهلي كان رد فعلها النمطي هو الرفض القاطع والكامل للغرب: رفضه بوصفه احتلالاً وهيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية، ورفضه بوصفه أسلوباً في الحياة والتنظيم. ولكن هذه المقاومة قد اندحرت في الأخير على الرغم من البسالة الأسطورية لبعض قياداتها ورموزها، وهو ما مهد لقبول ردي فعل نمطيين آخرين هما المحاكاة والتوفيقية التصالحية مع الغزاة. وعلى الرغم من إخفاق المقاومة الأهلية، إلا أنها قد نجحت إلى حد كبير في صون شخصية الشعوب الإسلامية من الاندثار وحفظت هويتها من الضياع، وضمنت نوعاً من التواصل التاريخي والثقافي الاجتماعي للشعوب الإسلامية في مواجهة زحف شمولي يريد أن يقطعها عن الأصول والهوية والتاريخ.
أما المقاومة الثانية أو ما اصطلح على تسميته بالحركات الوطنية -وهي الحركات التي نشأت في صفوف الفئات الحديثة- بعد أن قطعت الغلبة الأوربية بعض الشوط في تركيز علاقاتها الرأسمالية والسلطوية والثقافية وفي بناء أجهزة الحكم ومؤسسات الإدارة الحديثة، فإنها نشأت لكي تنازع القوة المسيطرة على “اقتسام الأَوْرَبة” وعلى حصة اقتصادية وسياسية. ولقد أخفق هذا الخيار في تحقيق النهضة الحضارية، ذلك أن الإصلاح في ظل التسليم بالغلبة والتفوق الحضاري للغرب يعني تغيراً وتقدماً وتحديثاً وفقاً لنموذج الغالب والمتفوق في الحضارة والثقافة، مما يؤول إلى مزيد من الاختلال والتفسخ في الهيئة الاجتماعية للشعب المغلوب. إن المسألة المركزية بالنسبة لتيار المقاومة الشاملة الأولى مسألة سياسية، ولم تكن مسألة ثقافية وتربية وتعليم وإصلاح جزئي. أما بالنسبة للمقاومة الثانية أو الحركات الوطنية فقد أدت ظرفية الاختراق والضغط الأوروبي بالمفكرين للتعاطي مع الأفكار الاجتماعية والمبادئ السياسية الغربية لتنظيم المجتمع والتسليم بها واقعاً لا مفر منه. ولكن موقفاً من هذا القبيل كان يعني مزيداً من الإرباك والتفكك والانقسام الداخلي والضعف والتآكل. لقد استطاع المشروع الإمبريالي أن يحتوي الصراع على أرضية علاقاته السياسية والاقتصادية وضمن منظوره ومفاهيمه، فأصبح السؤال الذي تطرحه الحركات الوطنية هو كيف نسرع في بناء الدولة الحديثة، وفقاً للنموذج الغربي؟
انكفاء الدين وغلبة مجتمع النخبة الحديثة: التغريب
لم يكن الاستعمار الغربي ليكتفي بالغلبة الظاهرة، وإنما كان يريد التوغل في عمق الإسلام لضرب القوة الباطنة، هذه القوة الكامنة في الدين برغم الهزيمة السياسية والعسكرية والانهيار الحضاري الشامل. وبما أن وجود الجماعة المسلمة ملتحم بالشرع، فإن نفي هذا الأخير وتطويقه وتهميشه وعزله بات يشكل هماً استراتيجياً عند الغالبين. غير أن واقع الهزيمة الكاسحة واستهداف عقيدة المغلوبين وثقافتهم ولحمة عراهم ورأس أمرها الذي هو الشرع، جعل المجتمع الأهلي لا يتردد في رفضه المطلق للتغريب وللخروج عن الدين، ولم يبق أمامه سوى التمسك بما يؤسس للجماعة كيانها، وبالتالي كان خياره أن يلجأ إلى الماضي بما هو ذكرى أمجاد وقوة يتعصب لها ويحتمي بها.
هذه العودة للماضي لم تر فيها النخب التحديثية إلا مظاهر للتقليد الأعمى، وترديد الظواهر الموروثة، وتكرار الحدث التاريخي في زمن دائري، وجمود الحركة، واختصار الحياة برتابة العبادة. وفي الحقيقة نحن هنا أمام حركة منكفئة تبدو كأنها قاربت الفناء، إلا أن ذلك لا يقود إلى الفناء. وإنه وإن لم تكن هذه المقاومة هي الحل المثالي الأفضل، إلا أنها مثلت مرحلة تاريخية دفاعية سمحت للمجتمع الإسلامي -في حدود معينة- بإعادة إنتاج نمط حياته ونسقها الخاص. غير أن النخب التي تفقهت على أساطين ثقافة الاستعمار في إطار تأهيلها لقيادة المجتمعات المتفسخة لم تر في هذه المقاومة وفي رموزها من النخب التقليدية إلا عائقاً أمام التحديث و”العصرنة”. وبعبارة أخرى رأت فيها حاجزاً أمام المجتمع النخبوي الحديث الناشئ في سبيل الانتقال السريع والنهائي إلى مواقع الثروة والسلطة. غير أنه بفعل هذه النخب المتغربة لم يعد التغريب وقفاً على جهود فردية بل تعدى ذلك إلى أن يصبح ثقافة وإيديولوجية مهمتها تعميم التغريب بتحويله إلى فكر ومؤسسات ودول، وباختصار تحويل الغرب بما هو ثقافة وحضارة ونمط حياة إلى حالة داخلية. وكان ارتداء التغريب “ثياباً إسلامية” يعني أن الستار الحديدي الذي ضُرب حوله قد بدأ يتهاوى، وبات التغريب يتسرب إلى داخل الجسم الإسلامي ليعلن بداية تناقض الجماعة مع ذاتها. وقد تم ذلك بوضوح في الدول الوطنية التي قد يكون الكثير من زعمائها استغل قيم المجتمع التقليدي ومشاعره الإسلامية لغرض تعبئة الجماهير بهدف الحصول على مكاسب سياسية في المدى القصير. وما أن تمكنت هذه القيادات من تحقيق تلك المكاسب كجلاء الاستعمار، حتى أعلنت الحرب على تلك القيم والمشاعر الإسلامية ذاتها. فقاد ذلك إلى مزيد من الانكفاء على الماضي والتعصب للقيم والتقاليد بوصفه السلاح الوحيد الباقي. وبهذا المعنى يظهر التعصب بوصفه علاقة فارقة تكشف الجماعة بواسطتها عن إرادة التمايز عن الغرب الغالب وعن موقفها الرافض للأمر الواقع.
تجربة التقدم الراهنة: فتنة الحداثة
تحررت الدول العربية من الاستعمار وانتقلت السلطة من أيدي المستعمرين إلى أيد وطنية، وكانت وسيلة ارتقاء مدارج السلطة الجديدة هي -إلى حد كبير- العلم والتربية ونظام التعليم الحديث. وإذا كان المطلبان الإصلاحيان الكبيران للمفكرين النهضويين منذ نهاية القرن الماضي هما إصلاح المؤسسة السياسية من جهة وإصلاح التربية والتعليم من جهة ثانية، فإن تحقيق هذين المطلبين كان ركيزة لبناء مجتمع النخبة -نخبة الدولة الحديثة- واستمراريته. ولقد استندت إيديولوجيا النخب الحديثة في النهوض بمجتمعها وإدراجه في سياق التاريخ العالمي إلى مفهوم مركزي هو مفهوم البناء القومي، وهو مفهوم يعد الدولة في العالم الثالث ضرورة لقيادة المجتمع نحو التلاحم الداخلي والتقدم الحضاري، وهو ما يشكل حجر الزاوية في إيديولوجيا “تقدمية” تمثل مصدراً لشرعية الدولة الحديثة. إلا أنه بعد أربع عقود من وهم البناء القومي وبناء الدولة الحديثة لم يتحقق الهدف المنشود بل تحقق عكسه. فالسيادة الوطنية تحولت إلى تبعية شاملة، والشرعية الداخلية تحولت إلى حكم القوة، والتنمية والتلاحم الداخلي إلى تنمية للتخلف، وتفكك اجتماعي وقومي متزايدين. فأصبحت دولة البناء القومي دولة للخراب القومي، وتحولت دولة المجتمع والأمة إلى دولة عداء للمجتمع وقهر للأمة، وأضحت الدولة الوطنية مجرد وكالة لقوى أجنبية. ولم تشهد المجتمعات العربية الإسلامية في ظل دولة التحديث لا إدارة عقلانية للموارد وتوزيع الثروة، ولا اندماجاً للمجتمع في السياسة أو للسياسة في المجتمع. وظهرت الدولة الحديثة -وخاصة أثناء الأزمات- على حقيقتها قوة أكثر همجية وأكثر انحطاطاً من نموذج الدولة السلطانية القديمة.
أما على الصعيد الثقافي وصعيد الوعي، فإنه عندما لم تنهض الذات التراثية من كبوتها ولم تحقق التقدم والتحضر وبقي العالم العربي على حاله، لم تجد النخب الحديثة من تفسير لهذا القصور إلا في التراث الذي نظر إليه على أنه قيد يحرم الوعي من الانطلاق نحو العصر وقيمة ومنتجاته. ولكن في الحقيقة فإن مشروع الدولة الحديثة والتقدم العصري، وهو المشروع الذي قاد المجتمع والدولة العربيين خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعني أن نقد الفكر التقليدي أو السلفي عمل تضليلي، لأن الفكر التقليدي فكر مغلوب لم يكن في موقع سلطة القرار طوال المرحلة الماضية، وبالتالي فهو غير مسؤول عن الكوارث التي آل إليها المشروع التحديثي العربي.
لقد انتهى على الصعيد الثقافي صراع الأصالة والمعاصرة مع نشأة دولة الاستقلال بنصر كاسح للتيار العصري، تيار الحداثة. وظهر صراع جديد بين يمين الحداثة ويسارها وعلى ساحتها الداخلية، أي أصبح صراع النخب العربية -بعد أن كان صراعاً بين القديم والحديث أو بين الفكر الديني والفكر العقلاني- صراعاً بين مدرستين في فهم القرب ذاته: المدرسة التقدمية الاشتراكية والمدرسة المحافظية البرجوازية. وغُيب الفكر التقليدي عن ساعة الصراع وإدارة الشؤون العامة لصالح فكر الحداثة بشقيه، فكيف يحمل هذه الفكر المغيّب نتائج تجربة لم يشارك في صياغتها؟ وفي هذه الحالة يكون السؤال الحقيقي إنما هو السؤال الذي يطرح للبحث والنقد حصيلة قرن أو أكثر من تجربة الحداثة العربية التي انتهت إلى ما يسمى “عصر الأزمة المفتوحة” أو “الانهيار الشامل” أو “الانحطاط المعاصر” أو إلى ما سماه المفكر الجزائري مالك بن نبي بالتكديس بدل البناء. فهل شهد الوضع العربي مع الأنظمة والنخب التحديثية الموجهة لدفة السياسة والثقافة والاقتصاد نهضة وحداثة؟ وهل قامت النهضة أم لم تقم؟ ولماذا لا يُسأل عن هذا الانحطاط والتخلف العربيين الراهنين دعاة الحداثة والمبشرون بها؟ أليس لاستمرار ذلك وتفاقمه علاقةٌ مباشرة بوجود تجربة الحداثة والنهضة المعاصرة وما نتج عنها من تحطيم للتكوينات الاجتماعية السياسية الثقافية التقليدية، ومن تركيز للسلطة واختلال للتوازن لصالح أجهزة الدولة التي انفصلت كلياً عن المجتمع، ومن تزايد القدرة على القمع من خلال تحديث أجهزة القهر وآلاته المستوردة؟
وأخيراً فإن الحداثة -كما طبقت في المجتمعات العربية الإسلامية- قد أضرت بإمكانية النهضة والتقدم الحقيقيين والنافعين. وقد أثبتت الوقائع التاريخية أن الأرضية الغربية التي سادت في بلداننا باسم شعار الحداثة لم تأت لتحقيق تقدماً وتطوراً، بل دمرت عوامل التقدم والرقي حين حطمت مصادر الاستقلالية في النسق الاجتماعي الحضاري العربي الإسلامي، ذلك أن المحاولات النهضوية الإصلاحية لم تكن بمادة الكيان الحضاري التاريخي تطويراً وتعديلاًن بل كانت انخلاعاً أو عدولاً عنه إلى وافد خارجي غريب، وهو ما يعني أن الخلل في مشروع النهضة بدأ مبكراً منذ تجربة محمد علي والطهطاوي، مروراً بطروحات محمد عبده ورشيد رضا، وانتهاءً بمدارس التحديث في دول الاستقلال حيث تحولت جرعة التغريب والتفرنج أو “الأوربة” إلى عنصر رئيسي بل العنصر الوحيد في مشروع اختيارنا النهضوي، في حين كان الهدف منها التنوير والإحياء والمراجعة وليس أكثر من ذلك.
لقد أنتجت الحداثة مجتمعاً عاجزاً مفتوناً منقسماً على نفسه بين جموع شعبية مجهَّلة مفقَّرة، مقصاة من كل الثمرات الإيجابية للحداثة، حاملة وزر هذا التحديث المغشوش، ومجتمع نخبة “أقلوي” (نسبة إلى الأقلية) منفصل عن المجتمع التقليدي وقيمه وثقافته، مجتمع يعيش فكرياً وعاطفياً في دول الغرب وعواصمه ويقدر على التفاهم مع المجتمعات الغربية أكثر من قدرته على التفاهم مع مجتمعه الأم.
وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال الفكر العربي لم يدرك بعدُ أن الحداثة يمكن أن تكون عنصر تفكيك وتدمير. ومع ذلك ليس المطلوب إلغاء الحداثة، بل المطلوب السيطرة عليها. إن المطلوب هو الوعي بأن الحداثة من موقع الغلبة السياسية والحضارية الشاملة لا يمكن أن تنشر وتعمم إلا الفتنة والتفسخ والتفكيك، وأن المسألة الأساسية هي: كيف يسيطر المجتمع الأهلي أو الأمة على الأدوات التحديثية كي لا تتحول إلى أدوات تدمير، بدل أن تكون أدوات إعادة بناء المجتمع والأمة.
وفي النهاية يخلص الباحث إلى أنه قد فات أوان الاختيار الموضوعي بين الأصالة والحداثة، أو بين الموروث والوافد، ذلك أن هذا الصراع قد وقع تجاوزه ولم يعد قادراً على إنتاج الأسئلة والإجابات الموجهة لإمكانات النهوض. فمضمون النهضة الحضارية المأمول أن تسير نحوها الأمة تواصلاً مع منطق الاستمرارية التاريخية هو تحرير الإنسان من عبودية الأصنام السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية كافة، ومن دون ذلك لا يمكن للتقدم والحداثة أن يكونا صالحين ونافعين.
خلاصات وملاحظات:
تتميز هذه الدراسة بطرح الأسئلة أكثر من اهتمامها بالأجوبة الجاهزة. وقد نجح الباحث في إثارة العديد من الأسئلة وفي تصويب أسئلة أخرى مطروحة من قبل وفي تدقيقها وتعديلها. فعدل سؤال الأمير شكيب أرسلان: “لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟” إلى سؤال جديد يكمل هذا السؤال ويدققه هو: لماذا لم نتقدم نحن بعد زهاء قرن من محاولات النهوض والتقدم؟ وبذلك يكون الباحث قد وجه إصبع الاتهام إلى النخب والدول التي تبوأت قيادة مشروع النهضة والحداثة وانتهت به إلى الفشل الذريع والأزمة المفتوحة والانكشاف الشامل. ثم يتساءل الكاتب عن طبيعة النهضة والحداثة التي جربناها وهل كما شهدنا نهضة وحداثة؟ أم كانت جهود النهضة والتحديث مجرد تكديس بدل أن تكون بناء، ويتساءل كذلك عن كيفية سيطرة المجتمع الأهلي على الأدوات التحديثية كي لا تتحول إلى أدوات تدميرية.
لقد نافح الباحث عن الثقافة التقليدية -ثقافة المجتمع الأهلي والأمة أو ثقافة المغلوبين- وأنصفها في ظل هجوم مركز ضدها، وأدان المنهج التوفيقي الذي انتهى إلى أن يكون جسراً يعبر من خلاله التغريب إلى عقر الإسلام ووطنه، وبين عجز مفكري هذا المنهج عن استعاب تاريخية المفاهيم وارتباطها ببيئتها الاجتماعية والحضارية والشروط التاريخية لتكوينها وتبلورها، وانتهى إلى أن مفهوم الحداثة -كما شاع استخدامه والدعوة إليه في الأدبيات العربية- ليس له من محتوى حقيقي من الناحية المعرفية والعلمية، وأنه لا يقدم أجوبة وحلولاً تلقائية لمشاكل الأمة، متهماً مجتمع النخبة الحديث ودول الحداثة والاستقلال الوطني، وكاشفاً ما وصلت إليه تجاربها من كوارث على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وإذا كان الباحث قد أصاب في مجمل ذلك، إلا أنه في نقده للتيار التوفيقي وأثناء تأكيده تاريخية المفاهيم ونسبيتها وارتباطها بظروف نشأتها، يبدو كأنما جعل من الثقافات والحضارات قارات معزولة تفصل بينها حواجز وموانع تعيق تواصلها وأخذ بعضها عن بعض وانتقال القيم والأفكار فيما بينها، أي أنه كأنما ألغى التواصل و”التثاقف” بين الحضارات والمجتمعات، أو على الأقل قلص هوامشه إلى أبعد الحدود. وإنه إذا صح تاريخياً في تجربة النهضة العربية الحديثة أن منهج التوفيق والاقتباس قد انتهى إلى تقويض الثقافة الأصل وأدمج المجتمع العربي الإسلامي في تيار التغريب و”الأوربة” بشكل مشوه، فليس الخلل في التوفيق والاقتباس في حد ذاتهما وإنما في الشروط التاريخية والمادية والاجتماعية التي رافقتهما أثناء هذه التجربة. وإذا كان المؤلف يشير إلى ذلك في أكثر من مكان، فإن حملته العنيفة على التجربة التاريخية في التوفيق والاقتباس -وهي تجربة مخفقة- قد تثير بعض الغموض حول المبدأ من أصله، وهو مبدأ لا يجب الحكم عليه من خلال تجربة مخفقة، فقد كان ولا يزال الأخذ والاقتباس بين الحضارات وسيلة للتواصل والتوارث والإضافة والتجديد.
لقد انتقد الباحث تجربة التحديث العربية بعنف وكشف مآلاتها ومآزقها مسمياً الأشياء بأسمائها، وانتهى إلى اقتراح وجهة لمحاولات النهوض العربية تتمثل في خوض معركة النهضة على أرضية النضال من أجل الحرية وتحرير الإنسان من الأصنام الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية. ولكنه انتهى -كما رأينا من قبل- إلى أننا اليوم بفعل تراكمات محاولات التحديث قد فاتنا أوان الاختيار الموضوعي بين الأصالة والحداثة أو بين الموروث والوافد. فعلى أي أرض نقف إذن لخوض مشروع معكرة النهضة والتحرر؟ وهل بلغ بنا الأمر إلى حد التشكك في الأرض التي سنقف عليها لمحاولة الانطلاق من جديد؟ وهل انتهى حقاً زمان اختيار الأرض التي يسعنا الانطلاق منها؟ ثم هل بإمكاننا أن نختار -من أجل بناء ونهضة حقيقيين- أرضاً غير أرض الأصالة، قاعدة للانطلاق، منفتحة على إنجازات البشرية المختلفة لاستيعابها ودمجها في تربتنا الحضارية والثقافية؟
إن عمل فادي إسماعيل على أهميته الكبيرة وعلى الرغم من الجهد الذي قام به للدفاع والمنافحة عن الثقافة التقليدية والقيم الموروثة والجماعة المغلوبة ومقاومتها البطولية التي حفظت تواصل الأمة مع تاريخها وتراثها، إن ذلك كله على جلالة قدره وأهمية نتائجه قد أهدره الباحث من خلال النتيجة التي ختم بها بحثه، وهي الانبتات عن الأرض التي من المفترض أن يقف فوقها وينطلق من قاعدتها في مشروعه للتحرر مقدمة للنهضة والتحديث النافع، عندما تصور أن هذه الأرض قد فاتنا زمان الوقوف عليها بعد أن تراكم فوقها جليد قرن من التشويه والتحديث المغشوش.
إن الحرية اليوم في رأينا ليست إلا ساحة للمعركة من أجل استيعاب الحداثة وهضمها والسيطرة عليها والإضافة إليها، ولكن على أرض الأصالة والموروث الذي يظل في حاجة إلى إحياء وغربلة وتفعيل لمجمل قيمه وبقايا مؤسساته حتى يكون ذلك مدخلنا إلى تقويم الحداثة والإضافة إليها. وإذا كان اليوم من الصعب التخلص من ركام قرن ونيف من ثمار الجهود المركزة للدول والنخب في تحقيق أكبر قدر من التحديث الذي آل إلى المسخ والتشوه، فإن ذلك لا يجعلنا نتوقع إمكانية للنهوض الحقيقي على أرض ثالثة لا هي أرض التحديث ولا هي أرض الأصالة. وستظل أرض الأصالة والموروث هي وحدها الأرض المناسبة للنهوض إذا ما وقع تفعيل هذا الموروث وتجديد طاقته الحيوية.
وأخيراً فإن أي نقد يوجه لهذا العمل لا يمكن أن يقلل من أهميته بوصفه عملاً نقدياً جدياً يقدم كشف حساب صارم للتجربة العربية في التحديث والنهضة والنخب العربية التي وجهت سهام النقد والتفكيك للتراث وللثقافة التقليدية وللقيم الموروثة دون أن تطرح السؤال على سلامة مشروعها وجهودها التحديثية التي انتهت بالوضع العربي إلى تنمية التأخر والتخلف بدل تحقيق التقدم والتحديث.