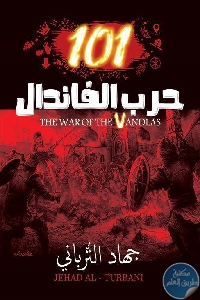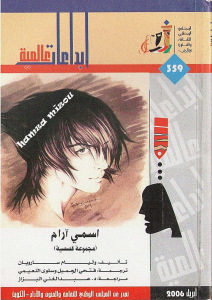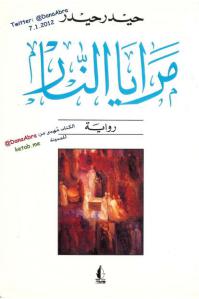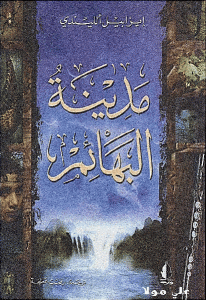كتاب أسد قصر النيل – رواية
 |
|
كتاب أسد قصر النيل – رواية المؤلف : زين عبد الهادي اللغة : العربية ترجمة : غير موجود سنة النشر : 2011 عدد الصفحات : 409 نوع الملف : مصور |
الفوضى العارمة التي اجتاحت المجتمع المصري ممثلا في مدينة (قاف) أي القاهرة خلال العقود الأخيرة هي ما يعبر عنه د. زين عبدالهادي في روايته «أسد قصر النيل».
المهم هنا ليس ما قاله في الرواية، فلعلنا جميعا نعرفه بكثير من تفاصيله التي وردت بها، وإن كانت للكاتب تحليلاته التي تخصه ولبعضنا أن يتفق معه فيها أو يختلف، لكن المهم هو محاولته التعبير عن فوضى الواقع والتاريخ بفوضى سردية موازية، ليكون التعبير عن الحالة من خلال تقنيات العمل الأدبى أكثر مما هي من خلال مضمونه، وهو ما يتسرب إلى عقل القارئ ويساعده على التواصل مع رواية ليست للقراءة المسترخية بأي حال.
الفوضى في معناها الأولي هي انتفاء النظام، وهو ما تؤكد عليه الأغنيتان اللتان ترتكز عليهما الرواية في ربط فصولها بنغمتيهما، أغنية زحمة يا دنيا زحمة لأحمد عدوية، وأغنية سمر واين أو خمر الصيف لنانسي سيناترا ولى هازلوود، واللتين ألحق الكاتب نصيهما بروايته باعتبارهما من وثائق الرواية، الأغنية الأولى تقدم معنى الزحام الذي يتسبب في الفوضى العارمة، ومن ثم العبث، والأغنية الثانية تعبر عن الأخلاق العبثية لهذا الزحام وحديها الخداع والوقوع في أسر لذة عابرة، غير مجدية لكنها آسرة.
لكن بناء الرواية يريد أن يصل بنا إلى أبعد مما تقوله كلماتها وحكاياتها ووثائقها، يريد أن يصل إلى معنى أعمق للفوضى، ألا وهو انتفاء الوجود ذاته.
ولكى يعبر الكاتب عن هذا المعنى استخدم تقنيات عديدة، ولعل محاولتنا هذه، الوعرة وغير مأمونة العواقب إطلاقا، هي الكشف عن النظام المختفى خلف الفوضى البنائية للرواية.
أنت تمسك بيدك كتابا ورقه من القطع المتوسط، عدد صفحاته 404 صفحات، غلافه أزرق عليه صورة متداخلة لأسد قصر النيل وأحمد عدوية وعلم مصر قبل ثورة يوليو، مكتوب على الغلاف باللون الأبيض (أسد قصر النيل) وباللون الأزرق (زين عبدالهادي) و(رواية). وعلى الغلاف الخلفي مقطع من الرواية، واسم دار النشر (ميريت) مع صورة لميريت الفرعونية رمز الدار. فأنت إذن تمسك رواية اسمها أسد قصر النيل كتبها زين عبدالهادي وأصدرتها دار ميريت للنشر، وما يطمح إليه زين عبدالهادي ليس مثل طموح كل كاتب أن تقرأ روايته، وتعجب بها، بل أن تقرأ روايته وتعتقد أنك واهم، فلا أنت تقرأ، ولا ما في يدك رواية أو كتاب، أنت نفسك؛ لو اقتنعت بذلك سيسعد زين عبدالهادي جدا، غير موجود هنا!!
ففى آخر صفحة من الكتاب تقرأ على ستة أسطر (كتب الرواية. فتحي السيد الصياد ابن العبد. يتسمى في أحيان أخرى باسم. زين عبدالهادي. اللقب المفضل دائما. زين) فهي رواية إذن، ولها كاتب هو فتحي السيد، وفتحي نفسه هو زين عبدالهادي، ولأنك قرأت روايته فلك أن تكون صديقه وبالتالي تناديه باسمه الأول الحميم زين.. وهي خدعة كبرى لن تنطلي عليك إلا إذا اكتفيت بقراءة هذه السطور الستة (!!) لأنك لو قرأت الرواية كاملة ستعرف أن زين عبدالهادي، وفي أحيان أخرى الدكتور زين عبدالهادي هو أستاذ في مجال المعلومات، وهو كاتب الرواية الأول أو الأصيل (أحيانا تثق في ذلك)، أما فتحي الذي لن تعرف اسمه إلا بعد صفحات كثيرة فهو سارد الرواية (أحيانا تظن ذلك)، ثم لن تستطيع أن تتأكد مما إذا كان أحدهما هو الآخر، أحدهما يرتدي قناع الآخر ليخدعك، أو ليتهرب منك، أو ببساطة لأنه لا يعرف نفسه أو لا يريد أن ينتمي إليها بالقدر الكافي فيتقنع بالآخر، وأحيانا يكون السارد هو قرين السيد زين عبدالهادي، وأحيانا هو الكلب الأسود الذي عليه أن يبيض!
ثم لا تلبث هذه اللعبة أن تتطور ليصبح لدينا أكثر من فتحي، وأكثر من زين، لأن الكاتب الأصلي الذي لم نعد نعرفه تماما خلق أكثر من سارد، وكل منهما قادر على أن يخلق ما لا نهاية له من الساردين، والمهم أن كل سارد قادر على أن يطلع على ماكتبه الآخر، وعلى نقد ونقض وتكذيب أو تدعيم ما كتبه الآخر، ونفي والشك وتأكيد عدم الثقة فيما كتبه هو نفسه، مما يدخلك في شبكة سردية واهية جدا مثلما هي شبكة الإنترنت، ومحكمة جدا مثلما هي شبكة الإنترنت أيضا، حيث تصبح ولا فكاك لك من تلك السرود المتوالية التي ينقض بعضها بعضا ويشكك بعضها في بعض، ويشكك كل سرد منها في نفسه أيضا، وبذا يجعل الكاتب رولان بارت يعيد النظر فيما قاله من أن «السارد والشخصيات هي: كائنات من ورق، وأن المؤلف (المادي) لسرد ما لا يمكن أن يلتبس في أي شيء آخر مع سارد هذا السرد» فلن تجد مؤلفا ماديا التبس مع سارد السرد مثلما التبس زين عبدالهادي مع فتحي الصياد ومع غيره من ساردى روايته العديدين، بل ولن يكون لتأكيد ولف غانغ كايزر «بأن السارد شخصية مبتكرة من طرف المؤلف» معنى عندما نكتشف أن المؤلف أصبح في رواية أسد قصر النيل هو شخصية مبتكرة من قبل السارد!
بل إن ما ذكره جيرار جنيت «في المستويات السردية علاقات الحكي بعضه ببعض، بحيث يختلف حكي عن آخر حسب تعدد القائمين بالسرد، وعلاقتهم بالقصة التي يحكونها، والانتقال من مستوى حكائي إلى مستوى آخر لا يمكنه مبدئياً أن يتحقق إلا بالسرد» لا يكون دقيقا تماما هنا، لأن الرواة يتعددون ويتداخلون ومستويات الحكي متقاربة، حيث لا تختلف أصواتهم ونبراتهم الحكائية رغم اختلاف وتماهي وتناقض ساردي الرواية!!
مما يوقعك في بلبلة يدعمها أن الأحداث الحياتية العادية تروى بتشكيك عظيم وكأنها لا منطقية أو غير قابلة للحدوث، وإن كانت قد حدثت فلابد أنها ليست بنفس الشكل التي تروى به، وكذلك الشخصيات العادية تقدم وكأنها نوع من الهلام أو الوهم، هي موجودة وتظن أنك قادر على لمسها، لكنك إن حاولت ستكتشف أنك تمسك الوهم، فتعود إلى صفحة 5 التي يذكر فيها الكاتب جملة تقريرية واحدة لن تستطيع التعامل جيدا مع الرواية إذا تجاهلتها أو نسيتها (العالم مجموعة من الأوهام التي نخلقها لأنفسنا أو يخلقها لنا الآخرون).
فى حين تقدم لك الأحداث والشخصيات غير المنطقية وكأنها الحقيقة الدامغة التي لا جدال في وجودها وحدوثها بالشكل التي قدمت به (مثل الرجل الذي يطلب من كلبه أن يبيض)، وهو ما يؤكده في صفحة 7 والتي تحتوى على فقرتين كل فقرة تحت رقم، الفقرة الأولى صيغتها إهدائية وإن لم يكتب الكاتب كلمة إهداء، ورقم الفقرة(1) ونصها (إلى الكلاب التي تبيض في صمت، وكذلك إلى الدول التي تنجب للعالم كل يوم وبلا أدنى تردد معتوها جديدا) لتصبح الحقائق الوحيدة في الحياة هي الكلاب التي تبيض، هي المستحيل، وكذلك المعتوهين، أي اللا نظام واللا عقل واللا إلخ.. الدكتاتورية ببساطة!
ينتفي النظام حتى في تشكيل الفصول، فإذا كانت الرواية توحي لك بالتتابع المنظم من خلال فصولها العشرين المتوالية، فإنها إنما توهمك بالنظام والتتابع لتزرع بداخلك الإحساس بنقيضه، حتى ينتفى في عقل القارئ النظام ونقيضه معا ليحصل بذلك على الوهم، فإذا كان كل فصل مكونا من عدد من الفقرات المرقمة، فإنك تجد فصلا يخترق هذه القاعدة كالفصل الخامس (فصل المقال في طيبة). وإذا كانت للفصول عناوين فإنك تجد فصولا تنفي هذه القاعدة مثل الفصل الثامن والحادي عشر وغيرها والتي وضع بدلا من العنوان دائرة صغيرة بداخلها نقطتان تحتهما نصف دائرة مقلوبة، بما يوحي بوجه مبتسم، والذي يوحي لك لأول وهلة أن هذه الفصول كوميدية أو تحتوي على سخرية مختلفة عن باقى الفصول، لكنك تكتشف أنها مثل باقى الفصول، فلماذا لا يضع لها عنوانا؟، كما أنه يضع لبعض الفصول جملا افتتاحية مستقلة قبل رقم (1) من فقرات الفصل، على سبيل المثال الفصل الثالث (مع كل نصر كنت أحرزه كنت أعرف أننى يجب أن أقاتل أكثر لأن نصري ما زال ضئيلا، ضئيلا للغاية، على الأقل ليس بحجم الحياة ذاتها) لكنه لا يصنع ذلك في كل الفصول، معظم الفصول يكتفي بوجود عنوان، ثم يفاجئك في أحدها بأن يعلق على العنوان ذاته بجملة جانبية مثلما في الفصل العاشر الذي عنوانه (لا يأس بدون رأي.. ولا رأي بدون حياة) فيكتب بخط أصغر في أقصى شمال السطر التالي (مع الاعتذار لمصطفى كامل)، وهذه الفوضى يؤكد عليها الكاتب بما فعله في صفحة 7 التي جمع فيها ما بين الفقرة رقم (1) بصيغتها الإهدائية، والفقرة رقم (2) بصيغتها الاقتباسية من أحد كتب حضارة المايا، حيث من المعتاد أن يكون الإهداء في صفحة، والاقتباس في صفحة أخرى، ثم تقرأ بعد آخر كلمات الرواية كلمة (البداية) وهي هنا ليست مجرد فكرة أن اللحظة الروائية الأخيرة هي بداية انطلاق حياة جديدة ربما تكون مختلفة أو أفضل، ولكنها تشير إلى الدوران اللانهائى حيث كل بداية هي نهاية لشيء وكل نهاية هي بداية لشيء آخر، لكنها هنا بالمعنى المشير للفوضى والإلتباس والغموض الذي يجعلك لا تدرك أين هي البداية من النهاية، بل إن الكاتب يرى أن النهاية الطبيعية لأحداث روايته هي نهاية الفصل الثامن عشر لكنه مضطر لكتابة الفصلين التاليين لأن لديه أكثر من مزاج لأكثر من قارئ (قد تكون هذه نهاية غير منطقية لأحداث غير منطقية، يمكنك الآن عزيزي القارئ أن تتوقف عن القراءة وتفكر معي في تلك النهاية، هذه النهاية لبعض القراء، أما النهايات الكلاسيكية فستأتي في الصفحات التالية، هذه كش ملك الإجبارية الأولى التي أتركها أمامك، يمكنك أن تستريح وتتوقف وتنام نوما هادئا، ويمكنك إذا كنت من أصحاب النهايات السعيدة أن تستكمل الحركتين الإجباريتين التاليتين لأن الملك قد مات بالفعل، لكنه لا يصدق) وهنا أستطيع أن أقسم أنني أعرف لون وطول لسان الكاتب الذي يخرجه لنا، فأي نوم وأى اختيار، لن يختار القارئ أن يتوقف عن القراءة، ولن ينام أو يسعد بعد الفصل الثامن عشر، كما أنه بالتأكيد لن ينام أو يسعد بعد الفصلين التاليين، فالكاتب يسخر من فكرة الرواية نفسها، إنه لا يكتب نهايتين إحداهما مفتوحة والثانية تقليدية، بقدر ما ينفى كل الفصول السابقة التي تحتاج إلى نهايات أصلا أيا كان نوعها، وهو يلاعب القارئ لعبة مرهقة ولذيذة، يتحدث إليه مباشرة وكأنه موجود، ويوهمه أيضا أنه حر في الاختيار، في حين أنه طوال الوقت ينفى وجود كل شيء بما فيه القارئ، وينفى القدرة على حرية الاختيار، وهنا يلعب استخدام لعبة الشطرنج في الكثير من فصول الرواية دورا محوريا، فهي من أكثر اللعبات دلالة على النظام الصارم، وبالتالى يمكن من خلال تكسير قوانينها والسخرية من هذه القوانين تعميق فكرة الفوضى، وهي لعبة الذكاء كما اشتهر عنها لأنها تجعل اللاعب يستخدم كل ما منح من قدرات عقلية لاختيار النقلة المناسبة، لكنها في الوقت نفسه لعبة الإجبار، فقوانينها الصارمة لا تسمح باختيار حقيقي، والذكاء مهما يكن إنما هو استعياب لهذه القوانين وليس خلق إبداعى بالمعنى المعروف، وبالتالي يضعنا الكاتب أيضا أمام فكرة عدم القدرة على التحكم الحقيقي فيما حولنا بما فيه اللعب ذاته، مما يكسر الثقة المفرطة بالنفس والتي يشعر بها الإنسان الحديث بلا مبرر حقيقي، وبكسر هذه الثقة يفتح الكاتب الثغرة التي يريد لسكب فكرته الأساسية في عقل القارئ.
لذلك يعاجلك بعبارة في الصفحة التالية للفصل الأخير (فالكاتب لا ينهي الرواية عند نهايتها ويتركك لنفسك) تقول العبارة ص393 (كل أسماء الشخصيات والأماكن في الرواية على الرغم من تشابهها مع بعض أسماء في الواقع إلا أنه ليست لها علاقة بها على الإطلاق.. وطبعا هذه بعض كلمات المؤلفين، الحقيقة لا يمكننى التأكيد على ذلك.. أنتم تعلمون الحقيقة) فهو يكتب لنا عبارة تقليدية لا تستخدم كثيرا حاليا، لكنه فورا ينفيها، ثم لا يستطيع أن يؤكد حقيقة أخرى مقابلها، ويترك للقارئ التأكيد مشيرا إلى أن القارئ هو الذي يعرف الحقيقة، هنا سخرية مرة، فبعد أن نفي كل حقيقة ممكنة، يمنحك وهما جميلا أنك فقط الذي تعرف الحقيقة. ثم يعاجلك الكاتب أيضا بتقديم (وثائق الرواية) ربما لتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، لكن هذه الوثائق تأتى ضربة أخرى ساخرة ومرة، لهزليتها وعبثيتها أولا، ولتأطيرها لفكرة الفوضى ثانيا، أشرنا من قبل إلى الوثيقتين الثانية والثالية لأغنيتي زحمة يا دنيا زحمة وخمر الصيف، أما الوثيقة الأولى فعنوانها (حادثة موت عمرو موسى عبد اللطيف على كوبري قصر النيل كما هي في الأصل) فالاسم الشهير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الجامعة العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بعد ثورة 25 يناير2011 يتم استغلاله في عنوان الخبر، كما تفعل الصحافة عادة في الأخبار الاعتيادية لتضخمها وتجذب القارئ، وهو ما يؤكد فكرة انتفاء الحقيقة وبيع الوهم، والخبر مقتطع من صحيفة المصري اليوم عن شاب انتحر لأن حبيبته تخلت عنه، وهي الفكرة المحور في حياة فتحي السيد، فهل فتحي السيد هو عمرو موسى عبد اللطيف، سؤال جديد بعد كل الاستفهامات السابقة حول الساردين العديدين، الفارق أن المنتحر يعرف قصة نفسه أما فتحي فإنه في كل مرة يعيد تذكر أو سرد سبب ترك حبيبته له يكتشف أو يذكر شيئا جديدا، لا ليكمل صورة ما ذكره من قبل بل لينقضه أو يشوش عليه، حتى لتظن في أحيان كثيرة أن قصة الحب هذه لم تحدث أصلا. أما الأسئلة التي يضعها القارئ بعد إيراد الخبر الصحفي فهي ذات دلالة كبيرة لما نذكره هنا فهو يسأل (السؤال الأول: لماذا اختار كوبري قصر النيل؟ السؤال الثاني: لماذا انتحر النحات صانع أسود قصر النيل؟ السؤال الثالث: لماذا سجل هؤلاء الروائيون حوادث الانتحار من على كوبري قصر النيل: 1-الراوى في قصة شروع في انتحار في مجموعة: العجوز والحب. عباس خضر. 2-بطل قصة متوازي المستطيلات. في مجموعة: خريف الأزهار الحجرية. ماهر شفيق فريد).
المغزى العميق الذي تراه قراءتنا هذه للرواية للأسئلة السابقة هو السؤال الكامن خلف كل هذه الأسئلة، لماذا اختار زين عبدالهادي نفسه أسد قصر النيل، ولا نستطيع الإجابة على هذا السؤال الذي يسأله الكاتب نفسه دون أن يصل هو إلى إجابة، لأنه ببساطة لا يريد إجابة، ولا يريدنا أن نجيب، بل يريدنا أن نفغر أفواهنا ونحن نسأل السؤال الأهم، وما أهمية ذلك؟ وهل هو موجود فعلا؟!
بل إنه، وفقا لقراءتنا هذه يصبح أحد الأخطاء غير المقصودة في الرواية ذا دلالة مهمة.. فالكاتب يشير في روايته إلى أشخاص حقيقيين بأسمائهم، ومعظمهم من الوسط الأدبي، كما يشير إلى البعض بأسماء مستعارة، أو يخلق شخصيات يغرزها في هذا الوسط وكأنها حقيقية، وبالتالي فلابد أن يكون بين هذه الأسماء ناشر، والناشر المثقف في الرواية اسمه راشد، ومن يعرف قليلا عن الناشرين لن يشك لحظة في أن راشد هذا نموذجه الأصلي هو محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، الدار التي نشرت الرواية ذاتها، لكن لمرتين تقريبا يحدث خطأ ويذكر اسم هاشم بدلا من اسم راشد، ووفقا لنا تكون دلالة ذلك هي أولا الخلط بين الحقيقة والوهم، وثانيا أن الفوضى الضاربة تطول كل شيء حتى هذا البناء الذي أقيم شديد التنظيم ليوحى بفوضى عقود من حياة مدينة (قاف) التي هي في الحقيقة، وفقا للرواية، أربع مدن شديدة الاختلاف والتنوع، والتعارض، وشديدة التداخل أيضا، فأى هذه المدن هي قاف؟ وأي هؤلاء الساردين هو المؤلف وأيهم السارد وأيهم هو زين عبدالهادي؟!